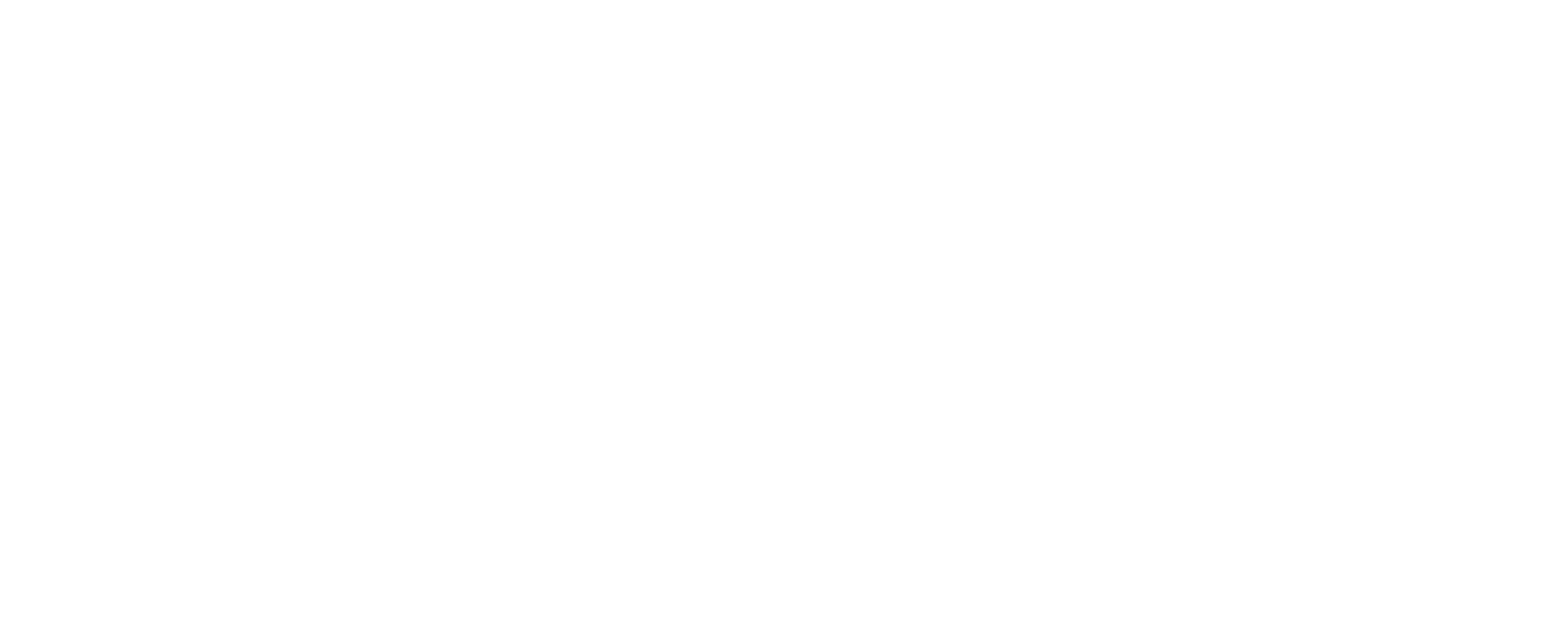قوله تعالى حاكياً عن قول وليه جل وعلا:
( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) (الفاتحة:5) ولم يقل: نعبدك ونعبد إياك، وذلك للمبالغة في إرادة العبادة له، وللمبالغة في صرفها عن غيره؛ لأن قولك: “زيد ضربته” أبلغ من قولك “ضربت زيداً”؛ لأن بعد قولك “ضربت” يمكن أن تصرفها عن زيد فتقول: تميماً، وأما قولك: “زيد ضربته” فلا يمكنك صرف ضربته عن زيد إن قصدت الضرب بمعناه.
بيــان:
وقال صاحب المثل السائر[7]: “إن في هذا الالتفات ما يدل على الإيجاب”، وقال صاحب الكشاف[8]: “ليس من دلالة الإيجاب”، والأصح ما قاله صاحب المثل السائر، ومعي أنه أعلم بالفصاحة منه بدليل قولهما هذا، وذلك مع صاحب كتاب المثل السائر، أنه لما شاهد هذا العبد من معرفة الله تعالى بمشاهدته لمخلوقاته تعالى في الدنيا، وما شاهده بعقله في الآخرة ما يدله على معرفته بنفسه ومعرفته بربه، فكانت مشاهدته تعالى بصفاته في مشاهدته لخلقه مشتركة، فلما أراد العبادة لله نحو الصلاة المكتوبة أو الدعاء بالتضرع والابتهال وجب عليه ترك مشاهدة المخلوقات، والتجرد بحضور القلب إلى الله تعالى، ومثال ذلك: من قاده الفكر إلى قدرة الله في شجرة أنه يقسم ما تشربه من الماء في كل عود، ولا يمنع الآخر صاحبه، وكذلك كل ورقة وكل عرق صغير أو كبير من الورقة، إذ الورقة باطنها كلها عروق متداخلة متقاربة مع بعضها بعض، فإذا حضرت الصلاة وجب عليه ترك ذلك الفكر في تلك الشجرة، فافهم ذلك.
بيــان:
وفي نون “نعبد” معانٍ كثيرة الإشارات إلى كثرة أمور منها:
أنها نون المتكلم إذا كان معه غيره من واحد فصاعد، فهي تستعمل لجماعة، وقد تكون للتعظيم كقوله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(الحجر:9)، والله تعالى هو الذي أنزله.
ومنها: تستعمل لتعظيم المذكور، كقول القائل للملك: نحن نطيعك، ولو لم يرد إلا نفسه، والمراد: أنت ممن لا يقدر أحد أن يعصيك، وكل ذلك يصح في حق الله تعالى، إذ لا يقدر أحد أن يعصيه إلا لمن أراد أن تظهر منه المعصية، وفي المعنى الأول أن يستعمله المتكلم إذا كان معه غيره، ففيه إشارة إلى التعاون على فعل الطاعة لله تعالى، وأنها في مواضع تكون أفضل، وفي مواضع تكون واجبة: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قدروا مع التعاون والجهاد إذا لزم، وقتال الدَّفْع إذا وجب، وأداء الشهادة، وفتوى العالم للمستفتي فيما لزم المستفتي ووجب، وهذا باب كثير يدخل فيه من الأحكام الشرعية يحتاج لإحصائه إلى مجلدات واسعة كثيرة.ٍ
بيــان:
وفي ذلك إشارة إلى صلاة الجماعة والحث عليها، وفي دلالة ذلك إشارة إلى لزوم قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها لا تتم إلا بها؛ لأن محل (نعبد) هي الصلاة، وكذلك الصوم والحج وأركان العبادة، ولكن الإشارة إلى صلاة الجماعة أقرب من غيرها؛ لأن الاجتماع لأدائها هي المندوبة، وأما الزكاة فيؤديها مفرداً بنفسه، وكذلك الصوم والحج، وكل ما ذكره في آية هو من الواجب على المكلف بأدائه، وإذا كان كذلك صح أن الابتداء بالبسملة لازم، ولا يلزم إلا في الصلاة، ولا تلزم إلا في قراءة الفاتحة فيها، فصح أنها آية منها، وأن الحكاية في (أبدأ) يُراد به الوجوب، إذ كل آية هي كذلك في الفاتحة، فلا يصح تخصيصها بعدم الوجوب دون غيرها، مع أنها قرنت بها في المصحف، وإن كان كذلك هي في كل سورة، ولكن كل سورة يصح أن يقرأ منها ما شاء المرء في الصلاة، ويترك منها ما شاء فبسملتها كذلك، وأما الفاتحة إنْ يترك شيء منها في الصلاة وهي الآية الأولى.
بيــان:
وفي نوني (نستعين) معانٍ إما في نفس الاستعانة فهي لازمة؛ لأن معناها التبري من الحول عن ترك شيء وعن معصية الله، ومن القوة أي القدرة على فعل شيء وعلى طاعة الله إلا بالله، وفي معناها دلالة على أن المستحب أن يكون السؤال لما يريد المرء بعد العبادة نحو بعد انقضاء الصلاة، وكذلك الدعاء إلى الله تعالى، فيشكر الله على ما أنعم عليه بإتمام أداء ما عليه، ويسبحه ويحمده ويُهلِّلُه ويكبره، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبرأ من الحول والقوة والطول إلا بالله، ويسأل الله ما أراد، والأحسن أولاً أن يطلب منه ما هو طالبه من التوفيق على طاعته، والعصمة من معاصيه، والاستغفار والتوبة من الذنوب، وقيل: على الكذب ينتقض الوضوء، ثم يختم بالصلعمة أي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأولياء الله أجمعين، وبالحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك معنى قوله تعالى (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ)(الشرح:7) أي فاجتهد، (وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ)(الشرح:8) أي في الدعاء، فاعرف ذلك.
بيــان:
وما في نوني (نستعين) يدل على أنه أشرك معه ذكر غيره، والاستعانة في الدعاء بعد الصلاة أو متى شاء المرء لا يشاركه فيه غيره غالباً، وإن أمكن فليس من المندوب إلا في مثل ما تحسن فيه الشركة كالدعاء في الاستسقاء عند عدم المطر، ولدفع بلاء عم الموضع وما أشبه ذلك، فيحسن أن تكون الإشارة إلى هذا المعنى.
والمعنى الثاني: أن ذلك بعده متعلق بصلاة الجماعة.
والمعنى الثالث: التبرك بأهل الله تعالى، وهم أهل رضاه عنهم من الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصبيان، وفي ذلك تذلل وخشوع لله تعالى، ومحبة الله بمحبة أهل طاعته، وولاية منه لهم وتعظيم لشأنهم، ونظر إلى أنه أحقر منهم وأنزل رتبة، وتنزيهاً من الإعجاب بنفسه، ومن تزكية النفس بالنظر إليها بعين الرضا عنها، إلى غير ذلك ما يطول بذكره الباب، ولما نظر إلى مراتب الفضلاء بعظم شأنهم إلى نفسه بخلاف ذلك قال:
( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة:6):
سأل لنفسه ولمن كان على طاعة الله محبة لله ومحبة لمن أحب الله فأطاعه ممن كان عبده في صلاة الجماعة، أو غيرهم على الإطلاق بأن يهديهم الصراط المستقيم، أي طريق الحق، والمراد بالهداية هدى البيان في كل أمر يعنيهم من أمر الدين، وأن يثبتهم على ذلك، وهو هدى السعادة والتوفيق للطاعة، والعصمة عن المعصية.
————————————-
[7] – هو نصر اللَّه بن أثير الدّين محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانيّ. ولد في جزيرة ابن عمر، شمالي الموصل، يوم الخميس الموافق للعشرين من شعبان عام 558هـ، وتوفّي يوم الاثنين الموافق للتّاسع والعشرين من ربيع الآخر عام 637 هـ في بغداد. كُنّي بأبي الفتح، ولُقّب بضياء الدّين، واشتهر بابن الأثير الجَزَرِيّ نسبة إلى جزيرة ابن عمر، وكتابه المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر: هذا الكتاب أكثر مؤلّفات ضياء الدّين بن الأثير أهميّة، ألفّه في الموصل في السنوات العشرين الأخيرة من حياته، ولم يكتف بإذاعته في النّاس، بل استمر يقلّب النّظر فيه تعديلاً وإضافة، وهو كتاب ضخم، يضمّ مقدّمة ومقالتين، تدور المقدّمة حول البيان وأدواته وآلاته، وحول الشاعر والكاتب وما يجب أن يتحلّيا به، أمّا المقالتان فالأولى منهما في الصنّاعة اللّفظيّة، والثّانية في الصنّاعة المعنويّة، والكتاب مطبوع متداول.
[8] – تفسير الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري جار الله.