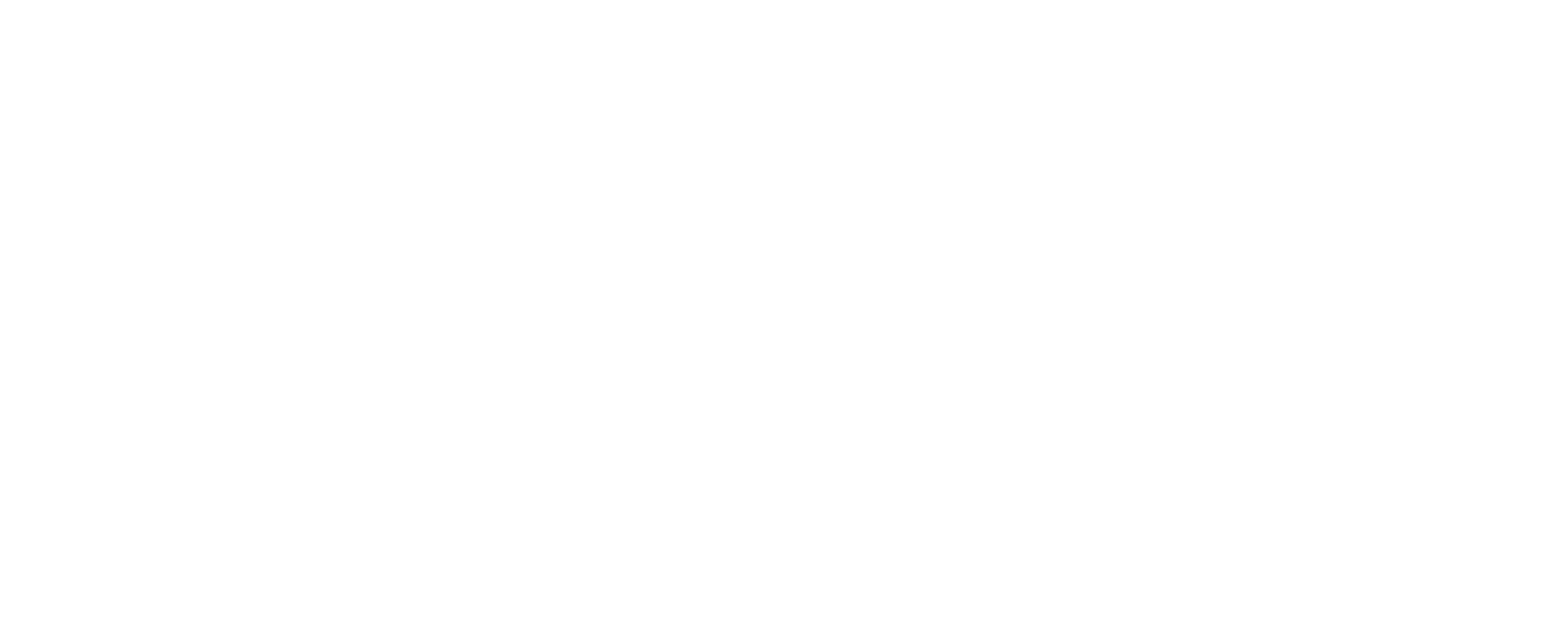السبب الثالث: التواصي بالحق: وهو ضمان الاستمرار على الأعمال الصالحة وعدم تأثير الشيطان على الإنسان، إذ الله تعالى طبع الإنسان على كونه جنساً اجتماعيّاً يتأثر فيه سلوك الفرد بسلوك مجتمعه، فالمجتمع يجب أن يكون مجتمعاً صالحاً طاهراً نظيفاً، وذلك لا يتمّ إلا إذا تعاون الأفراد جميعاً على تطهير مجتمعهم من كلّ رجس وكدر؛ بحيث يحرص كلّ أحد على استقامة غيره كما يحرص على استقامة نفسه، ومن أجل ذلك كان التواصي بالحق ضرورة من ضرورات الحياة البشرية لأجل الوصول بسلوك الناس إلى الغاية التي يُطمح إليها وهي الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يتمّ بإرشاد وتبصير كلّ إنسان لغيره حتى يتقي كلّ أحد ما يجب أن يُحذَر، وذلك داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الدعوة إلى الله عز وجل.
وهذه الأمة بالذات هي أمة دعوة، فلا بدّ من أن يتوفّر فيها هذا العنصر، فالله تعالى ميّزها بكونها أمة دعوة عندما قال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾ ، ويقول عزّ من قائل: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، وليس قوله (منكم) مفيداً للتبعيض، فإنّ (من) لا تفيد التبعيض هنا، وإنما هي لابتداء الغاية؛ أي كونوا أمة تتوافر فيها هذه الصفات، وهي الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدليل على ذلك أنّ الله تعالى بيّن منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج أتباعه حيث قال: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾، وأيّ الناس لا يحرص على أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم!!.
والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي إبلاغ أمر الله إلى عباد الله، فالداعية مطالبٌ بأن يحرص كلّ الحرص على أن يُرشد الناس إلى طريق الخير والسداد، وليس مسؤولاً عن نفس هداية الناس التوفيقية، فإنّ ذلك أمرٌ ليس هو في طاقة البشر، وإنما في إمكان الإنسان أن يهدي غيره هداية بيانية لا هداية توفيقية، ولذلك تجدون أنّ الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾، مع قوله له: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾، فهداية البيان من وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، بينما هداية التوفيق ما تُرِكت إليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ التوفيق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى.
فكذلك الدعاة ليس عليهم أن يقودوا البشر إلى طريق الخير بالتأثير على نفوسهم، وإنما عليهم أن يبينوا لهم ويدعوهم إلى الخير وِسْعهم، أما التأثير عليهم حتى يتحولوا من حال إلى حال فإن ذلك ليس من مقدورهم، وإنما من مقدور الله تبارك وتعالى، ولذلك سلّى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾، وبقوله: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾، وقال له: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾، وقال له: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾.
ومن هنا كان على الداعية أن يتصوّر أن المنهج المعتدل في الدعوة هو المنهج القرآني، بحيث لا يحمِّل الداعية نفسه أوزار الناس، ولا يفرِّط أيضا في دعوتهم إلى الخير، وتبصيرهم به، أما التفريط والإفراط فكلاهما يُفضيان إلى نتيجة سلبية، فالتفريط هو أن يتصور الإنسان بأنه ليس مسؤولاً عن الدعوة، وهؤلاء السلبيون كثيراً ما يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾، وهذا استدلال في غير موضعه، فإن الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ المراد لا يضرّكم من ضلّ إذا أنتم اهتديتم إلى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر1.
والمفرِّطون هم الذين يتصوّرون أنّ عليهم أن يوصلوا الناس إلى حقيقة الهداية، وهؤلاء عندما ينتهون إلى طريق مسدود يصطدمون بالأمر الواقع، وقد يُفضي بهم الأمر – والعياذ بالله – إلى أن يكونوا من بعد من المفرّطين، والمفرّطون هم مُتوعّدون من قبل الله سبحانه وتعالى؛ ذلك لأنّ الله عزّ وجلّ فرض على الناس التواصي بالحق، فمن لم يشارك في التواصي بالحق، والدعوة إليه؛ فلا ريب أنه مقصِّر في واجبٍ بينه وبين ربه، وهذا التقصير يفضي إلى خسارة الدنيا وخسارة العقبى، والله تعالى عندما تحدث عن بني إسرائيل في قضية السبت قسّمهم إلى ثلاثة أقسام: فريقٌ منهم اعتدى، وفريقٌ ثانٍ أمر ونهى، وفريقٌ ثالثٌ وقف موقفاً سلبياً، ولام أولئك الذين حمّلوا أنفسهم مسؤولية نهي أولئك عن مخالفة أمر الله، وقد بيّن الله تبارك وتعالى حال هؤلاء عندما قال: ﴿واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾، ولكن ماذا كانت العاقبة؟!
نجّى الله تعالى الذين ينهون عن السوء، وأخذ الذين ظلموا بعذابٍ بئيسٍ، والذين ظلموا وصفٌ يصدق على الفريقين: الذين اعتدوا، والذين وقفوا موقفاً سلبياً ولم يكونوا مع من نهى عن هذا المنكر؛ بدليل أنّ الله تعالى قال: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾.
———————————-
1- رواه الترمذي؛ الآية (2984)، وابن ماجه (4004).