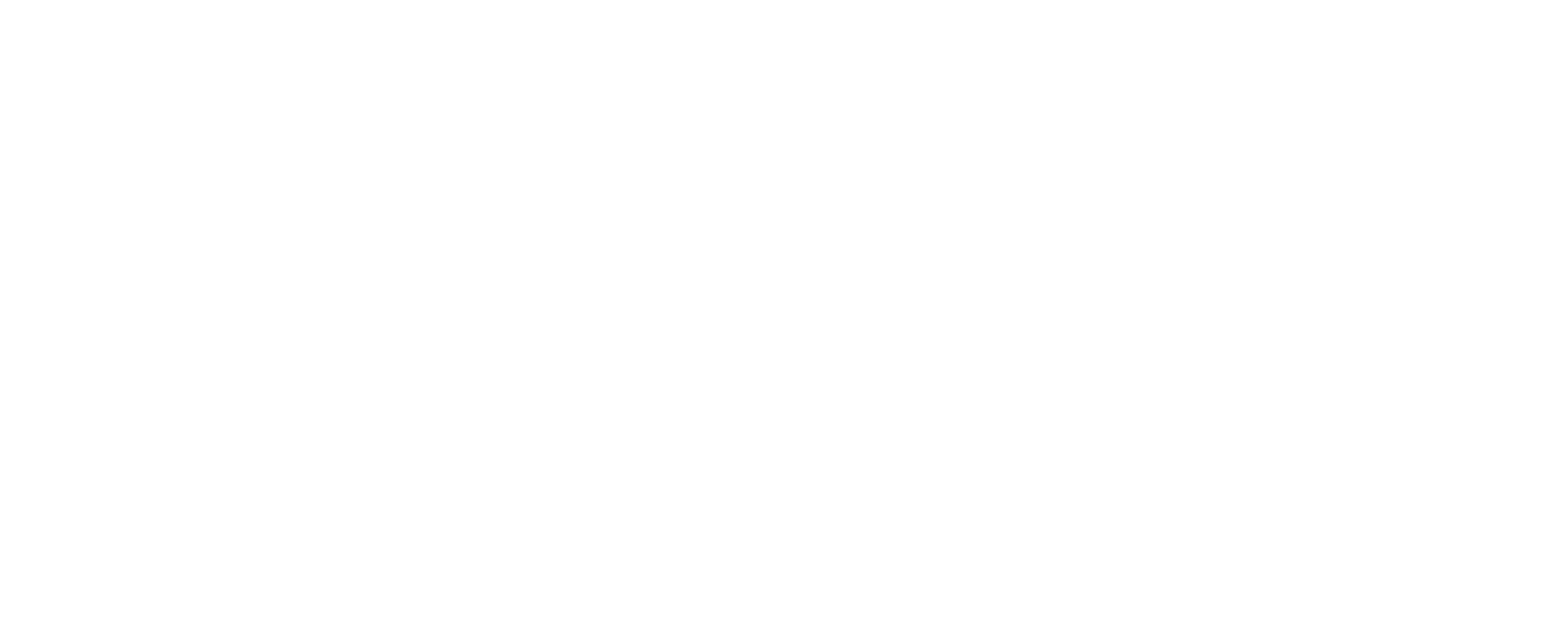بيان معنى الإيمان وجوهره:
كلمة الإيمان من حيث المدلول اللغوي هي بمعنى التصديق، يقال: آمن بالشيء، بمعنى صدّق، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه حين قالوا: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا﴾؛ أي وما أنت بمصدّقٍ لنا، ومادة الإيمان مأخوذة من الأمن؛ فكأن المصدِّق آمن محدِّثه التكذيب عندما صدَّقه1، وأما من حيث المدلول الشرعي فهو تصديق بقضايا معينة تصديقا تتفاعل معه النفس البشرية حتى تكون في كل جزء من أعمالها غير خارجة عما يقتضيه هذا التصديق.
والله سبحانه وتعالى بين جوهر الإيمان من خلال إخباره عن صفات المؤمنين، فقد قال عز من قائل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾، وفي قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ حصر بتعريف المسند والمسند إليه وتوسيط ضمير الفصل بينهما، ويقول سبحانه: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، ويقول عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾.
والنبي صلى عليه وسلّم يحدثنا عن الإيمان فيقول كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: «الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان»2، وذكرُ هذا العدد في الحديث لا يفيد الحصر، ولذلك جاء في رواية أخرى عند مسلم من طريق أبي هريرة أيضا : «الإيمان بضع وسبعون شعبة»3، وقد أفاد قوله صلى الله عليه وسلم: «أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» أنّ الإيمان ينطوي على العقيدة والعمل والأخلاق، فالعقيدة رَمَزَ إليها بقوله: «أعلاها كلمة لا إله إلا الله»، فإنّ ( لا إله إلا الله) هي قاعدة العقيدة الحقّ، والعمل رَمَزَ إليه بقوله: «وأدناها إماطة الأذى من الطريق»، والخُلُق رَمَزَ إليه بقوله: «والحياء شعبة من الإيمان».
وجاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان من طريق أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»4.
أول هذه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»، وجدير بالمؤمن أن يحبّ الله سبحانه وتعالى محبة تفوق محبة كلّ شيء، وجدير به أن يحبّ رسوله صلى الله عليه وسلم محبة تفوق حبّه لجميع الناس، وذلك لأن الحب إنما ينشأ غالبا عن أمرين اثنين: فإما أن يحبّ الإنسان غيره لاعتقاده عظمة ذلك المحبوب وتفوّقه عليه، وإما أن يحبّه لبسط يده إليه بالإحسان، وعلى كلا الأمرين فإنّ الله سبحانه وتعالى هو أحقّ بأن يحبّ من كل شيء، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخّر هذا الوجود بأسره للإنسان، فخلْقُه هذا الكون دليل عظمته، فهو الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو خالق هذا الوجود، الذي سخّر كل ذرة من ذراته فلا تخرج عن أمره، وهو الذي يحيط بهذا الوجود علماً وحكماً، وهو القاهر لكلّ ما عداه، فهو سبحانه وتعالى لا يُكتَنف عِظَمه ولا يُحاط بقدرته، وبجانب ذلك سخّر هذا الوجود لمصلحة الإنسان، فمن أحق منه بالمحبة!!.
والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين كما قال عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾، وهو بيانٌ تنقطع دونه كل لسان ويخسأ معه أيّ بيان، ذلك البيان الرباني الذي يعجز البشر أجمعون عن أن يأتوا بمثله، فالله تعالى يعلن أنه أرسل سيدنا ونبينا محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذه كلمة لها أبعادها الواسعة التي لا يحيط بها عقل بشر أبداً، فالله سبحانه وتعالى لم يقل: وما أرسلنك إلا رحمة للعرب، أو ما أرسلنك إلا رحمة لقومك، أو ما أرسلنك إلا رحمة للعباد، أو ما أرسلنك إلا رحمة للثقلين، أو ما أرسلناك إلا رحمة للأرض ومن فيها وما فيها، وإنما قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، والعالَمون جمع عالَم، والعالم يدخل فيها كلّ ما كان دليلاً وعلامةً على وجود الله ، فإذاً كل ذرة من ذرّات هذا الكون مغمورة بهذه الرحمة العظيمة ومشمولة بهذه النعمة الجسيمة، ذلك لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تستهدف الإنسان، وصلاح الإنسان يترتب عليه صلاح هذا الكون، لأن الله تعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض، وقطباً في هذا الكون تدور عليه رحاه.
وهو عليه أفضل الصلاة والسلام يفوق سائر البشر، قد اجتمع فيه ما تفرّق في غيره من الكمالات البشرية، فهو جدير بأن يُحبّ لعظم شأنه، وجدير لأن يُحبّ لما جرى على يديه من خير عظيم لهذه الإنسانية.
وإذا كان من شأن الإنسان المحبّ أن يسارع في هوى محبوبه حتى يذوب هواه في هواه، فإن الإنسان الذي يحبّ الله ورسوله لا بدّ من أن يترجم هذا الحب بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بدّ من أن يتفاعل هذا الإنسان مع كلّ أمر من الله تعالى، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الحق سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾، ويقول تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده»5، وفي رواية: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»6، ويقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية أخرجها البزار : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»7.
هذا .. وثاني الخصال التي يجد معها المؤمن حلاوة الإيمان ـ كما جاء في الحديث المذكور أولا ـ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وذلك أن المؤمن يحبّ أخاه المؤمن حبّاً جمّاً، فمحبّته له إنما هي بسبب صلته بالله سبحانه وتعالى، لا تكون لمنفعة مادية ولا لمصلحة دنيوية، إنما من أجل تلك الصلة التي تصلنا جميعا بالخالق العظيم تبارك وتعالى، فهذا الحب ناشئ عن حبّ الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون المجتمع المسلم مجتمعاً قويّاً مترابطاً برباط العقيدة الصحيحة.
وثالث خصال حلاوة الإيمان: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار؛ ذلك لأنّ الكفر ـ والعياذ بالله ـ يؤدي به إلى النار، والكفر يشمل كفر الشرك الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وكفر النعمة الذي هو اعتداء على حرمات الإسلام.
ويبين النبي صلى الله عليه وسلم حالة المؤمن فيقول كما جاء في الصحيحين من رواية أنس أيضا: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه»6، فالحديث يجسِّد الحالة التي يكون عليها المؤمنون، كيف يؤاخي هذا الإيمان بين عباد الله المؤمنين حتى تكون قلوبهم جميعاً كقلب رجل واحد، وقد مثَّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أروع التمثيل عندما قال: «مثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»8.
فإذاً نستخلص من ذلك أن الإيمان هو عقيدة راسخة يتفاعل معها المؤمن حتى تكون أعماله كلها ترجمةً لهذا الإيمان وتصديقاً له، فليس من الإيمان في شيء أن يؤثر الإنسان هوى نفسه على طاعة ربه، وأن يحرص على أن يستبدّ بالمصلحة لنفسه وينسى إخوانه في ذات ربه، فإنّ ذلك مما ينافي هذا الإيمان، وحسبكم أن السلف الصالح كانوا يعدّون مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى منافيةً للإيمان في أي شيء، فعندما أبصرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها امرأةً قد لبست ثياباً رِقاقاً، قالت: “ما آمنت بسورة النور امرأةٌ تلبس هذه الثياب”، ومِصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، فإنّ الله سبحانه عندما ذكرَ بني إسرائيل وذكرَ قبولهم لبعض ما جاء في التوراة، وإعراضهم عن بعض ما جاء فيها قال: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾، فجعل الرفض لبعض أوامر الله سبحانه وتعالى في الكتاب كفراً بالكتاب.
هذا .. وعند الرجوع إلى ما يقوله السلف الصالح في الإيمان نجد أن آراء السلف منطبقة تمام الانطباق على مفهوم الإيمان في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فقد أخرج أبو القاسم اللالكائي بسنده إلى الإمام البخاري أنه قال: “أدركت نحو ألف من السلف وما وجدتهم يختلفون في كون الإيمان قولاً وعملاً”9، وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أنّ غير واحد من علماء السلف حكى انعقاد الإجماع على ذلك10.
وقد يسأل سائلٌ فيقول: إن كان الإيمان يندرج فيه العمل الصالح فكيف يُعطف عليه؟!كما جاء ذلك في مواضع من الكتاب العزيز، ومن تلك المواضع هذه السورة.
والجواب: ما قاله بعض المحقّقين من المفسرين، وهو أنّ الإيمان إن عُطِف عليه العمل كان بمعنى العقيدة، وإن ذُكِر مطلقا كان بمعنى العقيدة والعمل.
على أننا يجب علينا أن ننظر في أركان هذه العقيدة، وكيف تجعل الإنسان يتفاعل معها هذا التفاعل بحيث تكون أعماله مترجِمة لهذه العقيدة، فالإيمان المطلوب من الإنسان هو ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره»11، فالإيمان بكل واحد من هذه الأركان الستة يقتضي التفاعل التام مع أمر الله سبحانه وتعالى، وبيان ذلك كالتالي:
—————
1-راجع: الجوهري؛ الصحاح (مادة أمن)، وابن منظور؛ لسان العرب (مادة أمن).
2-رواه البخاري (8)، ومسلم (51).
3-رواه مسلم (50).
4-رواه البخاري (13).
5-رواه البخاري (14)، ومسلم (63).
6-رواه ابن أبي عاصم في ” السنة ” ( رقم 15 ) والطبراني في ” المعجم الكبير ” ، وأبونعيم في ” الأربعين ” كما في ” جامع العلوم والحكم ” ( ص489 )، والخطيب في ” تاريخه ” ( ج4 / ص469 ) ، والبيهقي في ” المدخل ” ( رقم 209).
7-رواه البخاري (12)، ومسلم (64).
8-رواه البخاري (5552)، ومسلم (4685).
9-رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (284).
10-ابن كثير؛ تفسير ابن كثير 1/165
11-رواه البخاري (48)، ومسلم (9)