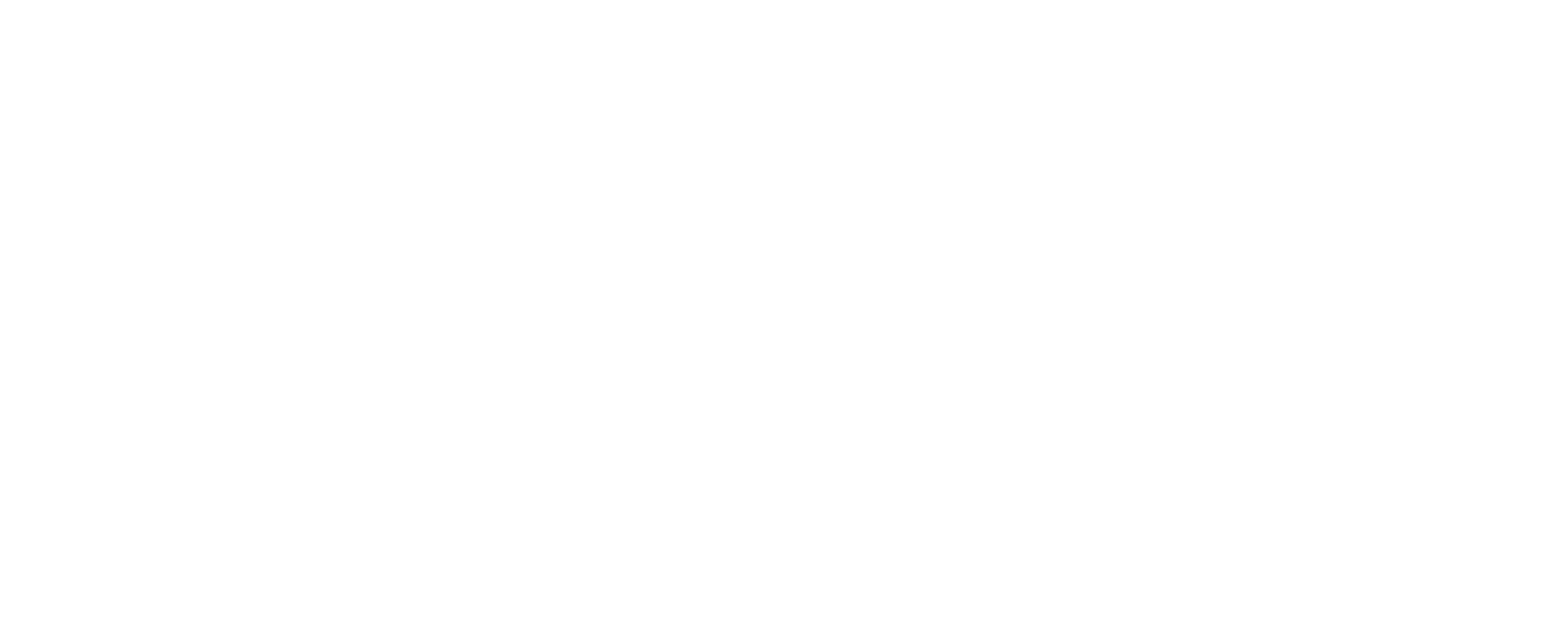بل فيه إشعار صريح بأن العارف لا يقر قراره ، ولا يزال مع الله اضطراره ، ولذلك تراه مع كونه من السائلة فيه يطالبه أن يرشده فيدله عليه رغبة في الوصال ، ورهبة من الانقطاع في المال بأسباب الضلال ، لكن زاده على طريق البدل ، تأكيدا له وبيانا ، لما رآه بالقلب عياناً ، إن عليه وله إليه برهاناً . فقال : (( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ )) بالهداية منك ، في السير فيه إليك ، على ظباء العلم ، في مطى العمل والحلم ، والبلوغ بالتوفيق ، إلى مقاعد التحقيق ، في قواعد التصديق ، لمّا له تجلى من خزائن الغيب نور برهان جلية الهدى ، فجلا من القلب دجى رين العمى ، وفاض على النفس تقوى قاهرة الهوى ، وسرى إلى الجوارح فجرها بأزمة الإيمان ، في ميادين الإحسان ، حتى وصلوا بالنعمة الإسلامية ، إلى النعمة الأبدية ، من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ، الذين ذاقوا لذة المعرفة وباشروا روح اليقين ، فاستغرقوا في المناجاة لا غيرهم ، لو كانوا في هذه الدنيا محاويج فقراء ، قد فقدوا الغنى وفرقهم البلاء في الحال باعتبار المال ، وكيف لا ، وهم ثمرته ! الكشف لقناع الوهم بسر العلم عن الدارين في بهجة رياض الرضا والسكون ، تحت مقراض القضاء والارتقاء ، من أرض الحظوظ إلى سماء الحقوق ، في مناص مقام الإخلاص ، قد فتح لهم لفناء النفس ، في مجالس الأنس ، باب الاستراحة بالسماع لغرائب ألحان مقال لسان الحال ، بأن ذلك من أجل هداياه والنظر إلى عجائب ما أودع فيه من ودائع أسباب ذرائع الوصول إليه بعطاياه ، فهانت بذلك عليهم عند ذلك مصائب الدنيا واستلذوا مراد الحق فيهم من حيث إنه لم يبق لهم اختيار إلا ما لهم بخيار ، وهم على منازل وأتباعهم منهم ، ولكل درجات مما عملوا .
والتخصيص لقوم موسى وعيسى عليهما السلام ، قبل أن يغيروا دينهم ضعيف ، وقيل هم الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، أو قيل هم النبي ومن معه ، وقيل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكون النصب له على البدل من الأول المشتمل على البيان ، والتكرير للثناء والتعظيم ، والدلالة على أن المستقيم طريق المهتدين من أولي الاستقامة في الدين على أبلغ وجه وأوجز عبارة .
وقرأ حمزة بضم الهاء فيما يروى ، والأكثرون بالكسر لها والضم للتاء والكسر لها لحن تفسد به الصلاة ، وكأنه في نفس الخطاب والتلويح يدل على التنبيه للمنعم على إيجاب شكر المنعم عليه بالنعم نعم كذلك .
ونِعَم المولى في الآخرة والأولى متعددة لا تحصى ولا تعد فتستقصى ، ولكن المراد في هذا الموضوع بالذكر لها في معرض الامتنان هي النعمة الدينية على الخصوصية ، وما وراءها تبع لها لمن قيدها بعقال الشكر لها لأن في مقابلتهما بالكفر لها تعرضاً لزوالها ، نعم حتى إنها تنقلب في حقه تلك النعم بالإضافة إليه من أشد النقم ، والدليل على هذا القول (( غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ )) ، فإنه من التأكيد بالمدح لوصف أولي الهدى ، في معرض القدح بالذم لذوي الردى ، بأسباب الإعراض وذي الأمراض بالزيغ الشديد ، عن الطريق السديد ، المقتضى لوجود الإخراج لهما عن مطلق النعمة ، والإدراج تحت النقمة ، فكأنه نوع استثناء لمزيد الكشف عن احتمال لبس عوارض الأشكال .
ولعله لذلك قرأت الراء بالنصب فيها – يروى عن ابن كثير – وللحال من الضمير في أنعمت بتقدير أعنى ، وكأنه من أوضح الأدلة في الخطاب على أن من كان كذلك حاله فليس على نعمة ، ولو أعطي الدنيا كلها ، وعوفي بدنه حتى انبسط في لذتها ، يتبوأ فيها على فراغ قلب كيف يشاء ، لأنه في هيكل ذاته أعمى مكبل بشهواته ، أصم محصور في سجن هواه معكوس ، مكب على وجهه منكوس ، يسحب مجروراً لمراس هفواته ، مردوداً إلى أسفل سافلين ، فكأنه في العذاب المهين ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . ولما كان الغضب غالبه ، يكون على أهل العناد احتمل أن يكونوا هم المهاجرين بالشر وأنواع الفساد ، والضالين ساكن الألف من غيرهم ، وقرئ بالهمزة – فيما يروى – هرباً من التقاء الساكنين ، هم الملحدون جهالة عن الشروع في هذا المقصد المشروع غباؤه ، لأن الضلال ميل في غوى ، لكونها مصدر ضل عن الشيء إذا أخطأه لعمى .
وتخصيص اليهود والنصارى بالغضب ، دون غيرهم من الراكبين كبائر ما تنهون عنه من المشركين والمنافقين ينتقض بآية اللعان ، والتعمد على القتل ظلماً وكأنهما في الظاهر لوجود الواو العاطفة المقتضية المشاركة مع اختلاف الصفة فريقان ، ولكن الغضب كأنه لهما شامل بالنسبة والمعنى ، والضلالة كذلك لكون الغضب على من عصى الله ، ولا يعصي إلا من ضل لا محالة ، لأنه عاص جزماً ، بدليل أن غضب الله عبارة عن عقابه بأليم عذابه ، جزاء لمن عصاه واتبع هواه ، فكأنهما بمعنى ، لأنهما مترادفان على مسمى ، إذ ليس أهل التكليف أجمع إلا فريقين وإن اختلفت الأحوال منهم في المعاصي والطاعات ، فريقاً هدى ، وفريقاً حقت عليه الضلالة .
والتقسيم في التسمية لهؤلاء نوع من التعريف في الظاهر على قسمين ، يحتمل أن يكون للإشعار بأن بعض الضلالات أفحش ، وأشد وأوحش من بعض ، وكلها في المآل تؤدي إلى أشر حال ، لكن كما أن للجنة درجات ، فكذلك للنار دركات ، وما منهم إلا له على مقدار الكفر والإيمان مقام معلوم منها ، ولا يظلم ربك أحدا . والعياذ بالله من غضب الجبار ، ومن المصير إلى دار البوار ، جهنم يصلونها وبئس القرار .
فانظر بعين البصيرة كيف على الصحيح استدلال أساس جميع العبادات كلها من العمل والعلم والدين ، لم تكن الموجودات إلا لأجلها فدار جملة واحدة تحت الجمل في هذه السورة ، فكانت هي المدار لجميع الكتب السماوية والمصنفات الأثرية ، حتى أنها لم تكن إلا كتفسير لها والتفصيل لجملتها ، والظن أن لهذا الاعتبار .
قال علي بن أبي طالب فيما عنه يحكى : لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب ، ولا غرو فإن الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أنا مدينة العلم وعليُّ بابها). والله أعلم . وبه التوفيق .