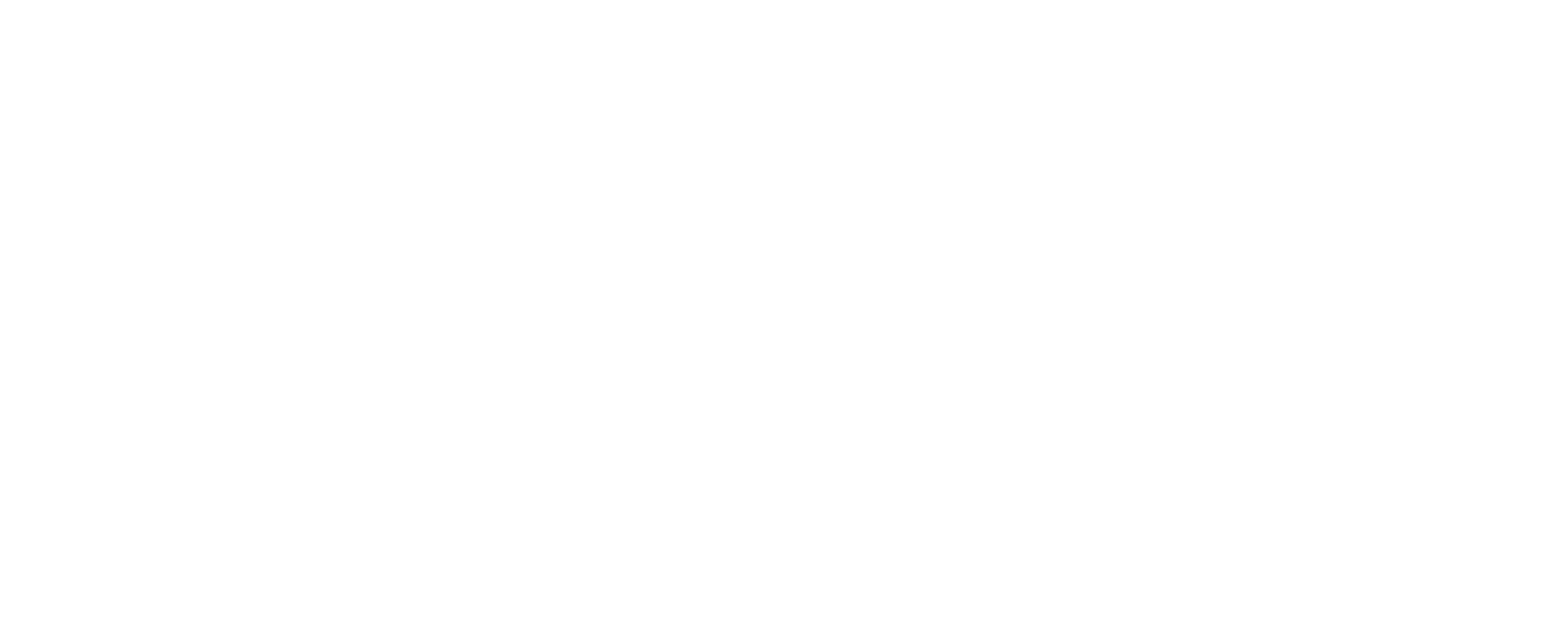الفصل الأول: في بيان بعض معانيها:
قوله تعالى (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة:1)
قال أهل التفسير: الباء هنا بمعنى ( أبدأُ باسم الله) أي باسم الله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال طلباً للأخف، وقيل: يصح أيضاً أن يكون الباء بمعنى ( أستعين باسم الله )، وأن المعنى أستعين بالله؛ لأن الاسم يقصد به المسمى كما قال تعالى: (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإكْرَامِ)(الرحمن:78) جازت القراءة في ذلك (ذو الجلال والإكرام) تبعاً لرفع (اسم)، وجازت (ذي) تبعاً لحركة الباء من (ربك) فيكون متوجهاً إلى المعنَيَيْن معاً[4]، ويكون معنى أستعين بسم الله أعم في الأمور؛ لأن معنى ذلك يعم الأمور كلها: من اعتقاد، ومن عمل، ومن ترك، من أمور الدنيا والدين جميعاً.
وأما على أنه معناه (أبدأ) وإن كان صحيحاً في التأويل ولكنه لا يعم أمور الاعتقادات، ولا أمور الترك، فصح أن المراد بذلك المعنيان، وأيضاً فإن الابتداء باسم الله بمعنى أبدأ بتلاوة هذه الآية لم يأتِ فيها نص إيجاب في شيء إلا في قراءتها في الفاتحة في الصلاة، وأما إن كان بمعنى الأمر الإيجابي لغير تلاوة الآية لغير مشاركة الباء، أي ابدءوا باسم الله فإيجاب ذلك في تكبيرة الإحرام، فيكون المعنى مشيراً إليها، وفي الذبح وفي مواضع أيضاً نُدِب، ولكن في غير ابتداء، فمعناه أستعين باسم أعم في الأمور، وبذلك يصح أن البسملة والباء من البسملة ضمنت جميع معاني القرآن العظيم؛ لأن الاستعانة تعم على جميع الأمور .
بيــان:
واعلم أن القرآن أنزل معاجزاً ومغالباً لشعراء العرب الفصحاء البلغاء في الفصاحة والبلاغة، العلماء بها منهم المنتهين غايتها فيما يعطي العباد منها، وإن كان كذلك مغالباً لفصحاء أهل النثر، لكنه إلى مغالبة أهل النظم أقرب، ولأنه ليس بنثر وإنما هو نظم، ولكنه غير موزون بموازين الشعر فلم يكن شعراً، والشعر نظم ولكنه موزون، وهذه إحدى المعجزات فيه؛ لأن نظم الشعر أسهل من نظم آيات؛ لأن الشعر يتبع فيه ميزان، فهو يمشي في طريق واضحة له، ونظم آيات يمشي وهو أعمى، إذ لا قائد له ولا سائق، ولما كان معاجزاً للشعراء، ولا يصح أن يغالبهم بما يخالف طرائقهم في أسلوب الشعر، إذ المتخالفان لا يصح التقابل بينهما، فلا غرو سلك به مسلكهم، وكأنه صحح مذهبهم فيه، وذلك أن لهم فيه شروط:
الأول: أنهم يبتدئون في القصيد بالتغزل والتشبيب بالنساء بالمدح، ويتغالون في المبالغة في ذلك، وفي حبهم وهيمانهم فيهن، وكأنهم يخاطبون في خلوات لا شاغل بينهما إلى غير ذلك إلى أن يخرجوا من ذلك إلى ما هم قاصدون ذكره.
والوجه الثاني: من الشروط في براعة المطلع أن تكون دالة على ما يريد أن يذكره في النظم في التغزل، أو فيما هو قاصد ذكره، فكذلك جعل الله الفاتحة هي كبراعة المطلع للقرآن، دالة على ما يريد أن يذكره في الكتاب كله، وكلما في الكتاب من المعاني هو في الفاتحة، وكلما في الفاتحة من المعاني هو في البسملة، وكلما في البسملة من المعاني هو في معنى الباء، وكلما في الباء من المعاني هو في نقطة الباء، بدليل أن كل ذلك في الباء إذا كان من معانيه في (بسم الله) أستعين باسم؛ لأن المعنى كذلك يعم جميع الأمور الدينية والدنياوية، الجائزة واللازمة، فعلاً وتركاً، والدليل على أن جميع ذلك في نقطة الباء؛ لأن نطق الباء فيه بالكسر، فهو ابتداء من أسفله، كأنه من النقطة بخلاف نطقه بالفتح والضم، وهذا من أعظم المعجزات فيه، أي القرآن العظيم، وجعل معنى الفاتحة على قياد طريقتهم، كأنه ولي لله تعالى يخاطب الله جل وعلا، ولم يعين اسمه، وبالغ في وصفه بالحكاية عنه في خطابه بها إلى ربه، إلى حد يعجز الواصفون أن يعرفوا حد كماله في الحب لله والخضوع والخشوع والتبتل إلى الله جل، والتذلل في التضرع إليه إلى حد يظن المرء أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ الغاية في الفضل في جميع المحدثات.
بيــان:
ولما كان التغزل في الشعر أن لو فعلوا ما يذكرونه لكان ضلالاً، ولو فعله غيرهم لكان ضلالاً أيضاً؛ لقوله جل وعلا: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) (الشعراء:224) أي حين يتلون أشعارهم، ويذكرون النساء تحركت الشهوة إلى الفعل، فإن فعلوا ضلوا، ولم يرد بذلك هنا ذمهم، وإنما يريد الاحتجاج بالقرآن للفرق بينهما أن طريقة الشعر لا يمكن فعلها، ولا يفعلها إلا الغاوون بدليل أنه نزههم عن فعلها فقال: (وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) (الشعراء:226)، وأما طريقة القرآن فمن اتبعها اهتدى ونال السعادة الأبدية، لذلك كان في مقابلة التغزل بالنساء مخاطبه هذا الولي لله بالفاتحة ليكون بخلافهم، وليكون دليلاً على ما سيذكره في الكتاب.
بيــان:
واسمه تعالى (الله) قيل: إنه اسم علم لا اشتقاق له، وقيل: إنه مشتق من اسمه تعالى الإله معرفاً بالألف واللام، وحذفت الهمزة للتخفيف فصار الله، فقصد به الذات فكان اسماً علماً للذات، لا يقصد به معنى صفة من صفاته تعالى، ثم فخمت لاماه فقيل: الله، إلا في اندراج الكلام إذا جاء قبله حرف مكسور بقي على التخفيف فقيل: بسمِ الله، والحمد لله.
وجاء رجل لعله من أهل المغرب إلى نزوى في زمن الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي[5] رحمه الله، يفخم لام اسمه تعالى الله مع كسر ما قبله، نحو: بسمِ الله، والحمد لله، فلما رُدَّ عليه قال: لأرقق نطق لام اسمه تعالى الله في كل موضع، فقال الشيخ سعيد بن بشير رحمه الله: لا تخطئوه عسى أنه نظر أنه الأصوب، هكذا حكي لي والدي[6] رحمه الله عنهما، ولأنه جعلها مسألة رأي، والأفضل الترقيق، مع تقدم حرف كسر أو جر عليه؛ لاتفاق القراء على ذلك بالشهرة.
واسمه تعالى (الرَّحْمَن الرَّحِيم) قيل: بمعنى واحد، وقيل: الرحمن أعم، أي رحمن الدنيا بالمؤمن وغيره، ورحيم الآخرة بالمؤمنين، والأول أصح.
بيــان:
ولا يصح أن يبدأ باسم الله مستعيناً به على أمر إلا وقد عرف عجز نفسه، وعرف صفات الذي يستعين به، وعرف الأمر الذي يستعين به عليه، فدل بذلك أنه قد كاشفه الله تعالى بصفاته، وجلال جمال كمالها، وكمال جمال جلالها، وجمال كمال جلالها، وأنه مع ذلك لولا عظم رحمته تعالى في كل شيء لتلاشى كونه في حين المشاهدة، فقال مستعظماً لكمال رحمته: الرحمن الرحيم، معناه كأنه يكرر ذلك على معنى من يقول معناهما واحد، أو على المعنى الآخر قال فلا يخالف قوله تعالى:
————————————
[4] – قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بواو بعد الذال نعتاً للرب وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون (ذي الجلال)، واتفقوا على الواو في الحرف الأول وهو قوله (ويبقى وجه ربك ذو الجلال) نعتاً للوجه إذ لا يجوز أن يكون مقحماً، وقد اتفقت المصاحف على ذلك.
[5] – سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي ( ت : 1150 هـ/ 1737 م ) فقيه مشهور وعالم جليل، عاش في آخر القرن الحادي عشر ، والنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري، له أجوبة كثيرة مبثوثة في كتب الفقه .
[6] – هو الشيخ الرباني جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى حفيد الإمام الصلت بن مالك الخروصي اليحمدي، ولد سنة 1147هـ في قرية العليا بولاية العوابي، ولقبه الرئيس المدقق، والد الشيخ ناصر بن أبي نبهان صاحب هذا التفسير.