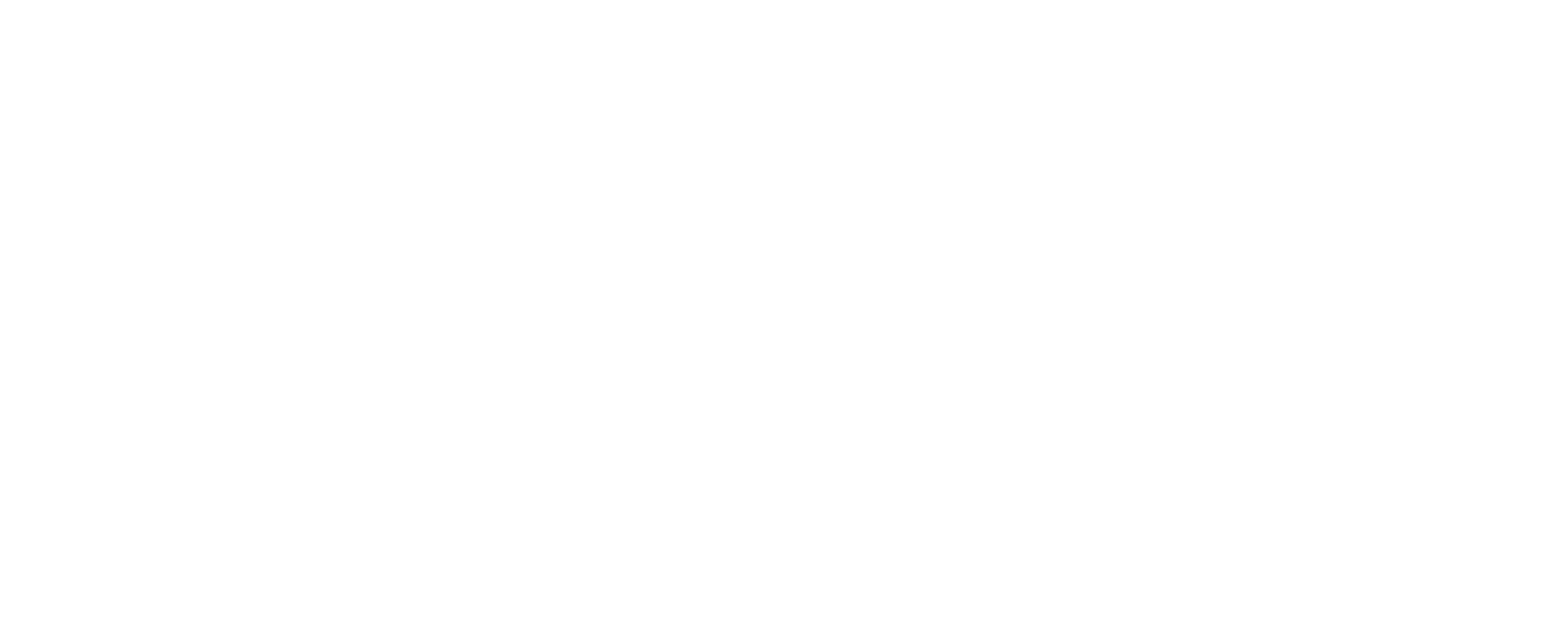﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾
ذكر الله في هذه الآية الأسباب التي تنتشل الإنسان من الخسران في الدنيا وما يترتب عليه من الخسران في الدار الآخرة، وهذه الأسباب التي تعتبر صمّام الأمان من هذا الخسران هي: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي الحقّ، والتواصي بالصبر، وسنحاول أن نتحدث عن هذه الأسباب بشيء من الإيجاز.
السبب الأول: هو الإيمان، والإيمان عنصر فعّال في حياة الإنسان، وبدون الإيمان يفقد الإنسان كل قيمة من قيمه، كما أنه يصبح في هذه الحياة حائراً متردّداً لا يعرف من أين جاء، ولا إلى أين يذهب، وماذا عليه أن يعمل في حياته هذه التي هي بين المبدأ والمصير، ولكنّ الإيمان هو الذي يحلّ له الألغاز، ويبصّره بأمره، ويرفع حيرته، وينتشله من هذا الضياع.
أثر الإيمان في نفوس أصحابه:
وحسبكم دليلاً على قوة الإيمان الفاعلة تأثير هذا الإيمان في سحرة فرعون، ماذا كان هدفهم قبل أن يلامس الإيمان شغاف قلوبهم؟ وما هو مطمح أبصارهم آنذاك؟ قد كان همهم محصورا في المنافع المادية فحسب، ولذلك قالوا لفرعون عندما جاءوا إليه: ﴿ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾، ولكن عندما وقر الإيمان في قلوبهم، وفتّح بصائرهم، وأرهف حسهم، وبصّرهم بحقيقة هذه الحياة، وحقيقة ما بعدها، ماذا قالوا لفرعون مصر؟ قالوا له: ﴿لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾.
هذا الإيمان نفسه هو الذي حول العرب مما كانوا فيه وعليه من الضلالة والضياع والتشتت، والأنانية والغطرسة والفساد في الأرض إلى ما انتقلوا إليه؛ حتى صاروا قادة الأمم في الخير، اجتمعت كلمتهم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أرحم الناس بالناس، يصفهم الأستاذ الكبير مصطفى صادق الرافعي عندما كانوا في حالة لم يلامس الإيمان فيها شغاف قلوبهم فيقول: “كانوا بين راع للغنم، وداع للصنم، وعالم على وهم، وجاهل على فهم، وإنسان كأنه من شره آلة لفناء الإنسان، وشيطان كأنه من خبثه مادته من جنس الشيطان”، ولكن بعد ذلك تحوّلوا إلى وضع معاكس وطبيعة مخالفة لما كانوا عليه، حتى صاروا كما يصفهم الأستاذ نفسه: “كأنما جاء هذا القرآن الكريم الذي غرس الإيمان في قلوبهم فأمسك بجزيرة العرب من طرفها، فنفضها تحت شعاع الشمس، فتفرّقت ذرّاتها على جميع أرجاء الأرض، وإذا بكلّ ذرّة وراءها عربي يحمل كتاب الله إلى الخلق داعياً إلى الله كأنما أُرسِل من قِبل الله بشيراً ونذيراً”.
وهذا الإيمان هو الذي انتزع السقائم والأحقاد التي كانت متوارثة في قلوب طرفي الأنصار الأوس والخزرج، بعد ما كانوا متناحرين متقاتلين مدة 120 سنة يتوارثون العداوات والثارات والتِرات ، وإذا بهم يتحولون إلى إخوانٍ متصافين في الله تعالى متحابّين فيه، وهذا الإيمان هو الذي جعل المهاجرين لا يبالون بما يتركونه وراء ظهورهم من مال وأهل وولد في سبيل نصرة الله ورسوله.
هذا الإيمان هو الذي جعل الأنصار تتفتح قلوبهم لاستقبال إخوانهم المهاجرين في دار الهجرة مع أنها دار محدودة المساحة ومحدودة الموارد، ومن شأن الناس أن يضيقوا ذرعا بالمهاجرين؛ لأنهم يشاركونهم في خيراتهم ويضايقونهم في أرضهم، ولكنّ الأنصار كانوا بخلاف ذلك، فكانوا يحبون من هاجر إليهم، وقد أثنى الله عز وجل على هؤلاء وهؤلاء ثناء يُتلى بلسان الدهر ما بقي الدهر، حيث قال: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ أيّ وصف أبلغ من هذا الوصف!! كيف أخرج هذا الإيمان جيلا من البشر كأنما هم مخالفون للبشر في طباعهم، أو كأن هذا الإيمان طوى هؤلاء الناس طيّاً، ونشرهم بعد ذلك نشراً بطباع غير طباعهم، وصفات غير صفاتهم.
هذا الإيمان هو الذي ألف بين العرب والعجم، فتآخوا في سبيل الله مترابطين من أجل نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله – صلى الله عليه وسلم- من غير التفات إلى تمييز أو عنصرية.
وهذا الإيمان هو الذي جعل الخنساء تحمد الله تبارك وتعالى على أن تقبل أولادها شهداء في سبيله بعدما كانت تنوح على أخيها ذلك النواح، وتلبس الصِّدار وتشق الجيب، وتحلق الشعر، وتفعل ما تفعله من أجل موت أخيها!!
فما هو هذا الإيمان الذي يقيم الإنسان في حياته على نهج سوي، ثم بعد ذلك يكفل له السعادة في الدار الآخرة؟