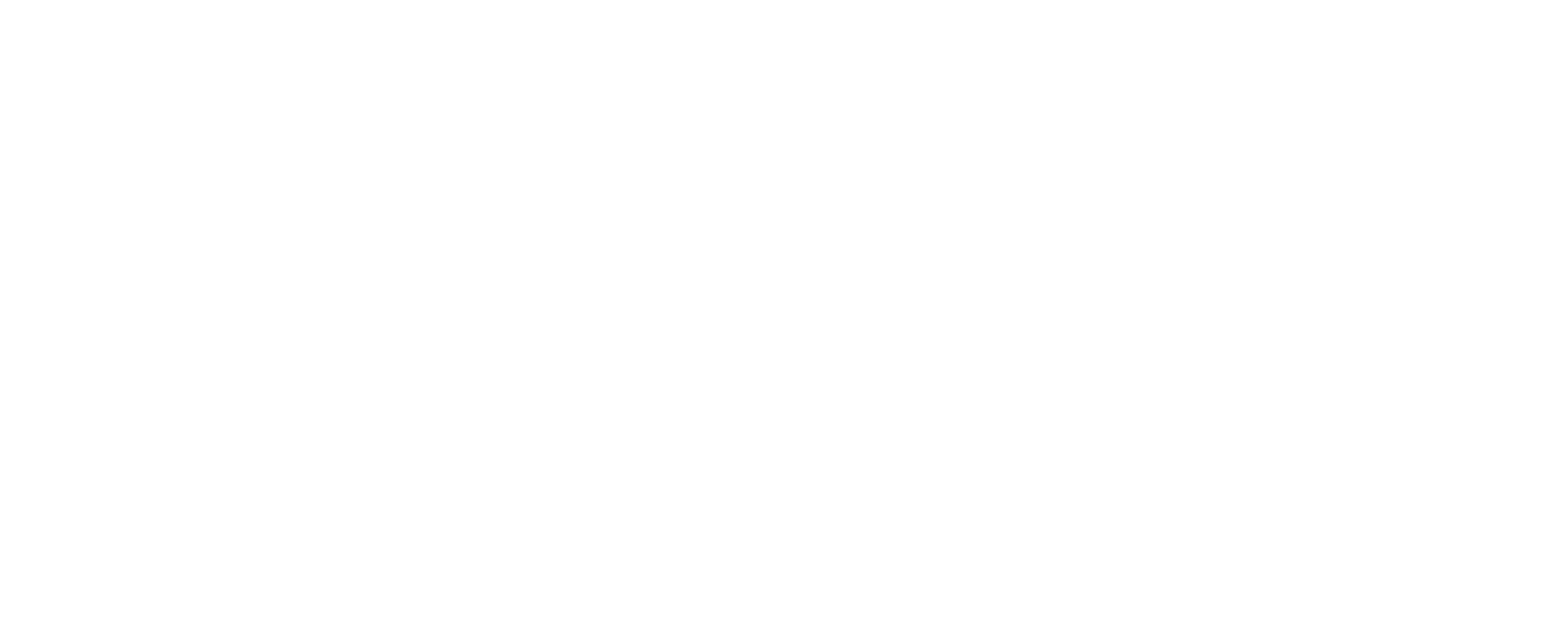عنوان الحلقة ” البــِــرُّ”
يقول الله تعالى: “لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ” ( البقرة: 177).
مقدم البرنامج: ما معنى هذه الآية؟ وعن ماذا تتحدث؟ وماذا يستفاد منها في موضوع البر؟
الشيخ كهلان: موضوع البر موضوع يطيب به الحديث، وقد يتشعب ويمتد ولا ينتهي هذا الموضوع، لأننا نتحدث عن البر الذي هو غاية الإحسان، عن البر الذي ينقي سريرة الفرد، فيضفي عليها من التصور والمعتقد ما ينتج أقوالا وأفعالا تؤدي إلى صفاء المجتمع، وإلى تواد الناس، وإلى تآصرهم على أخوة متينة، نتحدث عن خلال وخصال تضفي على هذا الإنسان انعتاقاً من الأوهام، والخرافات، وصلة متينة بالله سبحانه وتعالى، وتحوّل حياته بعد ذلك إلى ترجمة فعلية لحقيقة هذا الدين، تتجلى فيها الأخلاق السمحة، والخِلال الكريمة، والقيم والمبادئ التي جاء بها هذا الإسلام – أي مجموع هذه الصفات والخصال والخِلال – لدى هذا الفرد، فإنها لا تتجلى كعادة يتوارثها الجيل بعد الجيل، وإنما تتجلى بتأثير ذلكم الإيمان الراسخ، وتلك العقيدة التي ترسخ في قلب هذا المؤمن، ويعلم حقيقتها، ويعلم ما تريده منه، وما يريده منها.
وسوف نحاول قدر المستطاع أن نركز على ما نستطيع أن نستوعبه في حلقات هذا البرنامج ما يستفاد من هذه الآية الكريمة.
هذا السياق الذي وردت فيه الآية أولاً وهو سياق تحويل القبلة، وما دار من كلام من قِبل المغرضين من المنافقين، ومن اليهود، وبعض أهل الكتاب، والمشركين، تأتي هذه الآية لتبين للناس جميعا أن حقيقة الإيمان إنما تتجلى في هذا الذي سماه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بالبر.
وصدّر صفات هذا البر أول ما صدّر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وباليوم الآخر، وبالملائكة، والكتاب، والنبيين، وكثير من أهل العلم يقولون: بأن إفراد كلمة” الكتاب” إنما هي لاستغراق الجنس، ولا يقصد بها القرآن الكريم فقط، بدليل عطف “والنبيين” ، والأنبياء أنزلت عليهم كتب شتى.
ثم بعد الحديث عن العقيدة والإيمان انتقل إلى بعض أعمال يطلب من المسلم أن لا يفرط فيها “وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ…” وحينما يتأمل المرء في كل واحدة من هذه الأصناف التي عددها الله سبحانه وتعالى، فإنه يتبين له من الأسرار والمعاني ما يدعو إلى تلاحم هذا المجتمع، وإلى تراص صفه، وإلى تآلف قلوب أتباعه، حتى حينما يتعلق الأمر بما هو جِبِّلة لدى هذا الإنسان من شدة تمسكه بالمال الذي عبرت عنه هذه الآية الكريمة في هذا السياق بقوله تعالى : “عَلَى حُبِّهِ”.
ثم يأتي الحديث عن ما يعلمه الناس من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده “وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ” ، ثم من أهم خصال الأخلاق التي تُطلب من المسلم هي الوفاء بالعهد حينما يعاهد، والصبر في كل الأحوال، والصدق، فالله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله: ” وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ..” ونصبت الصابرين هنا على سبيل المدح، أي وأخص، أو وأمتدح كما هو رأي جمهور المفسرين،” وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ”، فإذن: هؤلاء هم المؤمنون حقا، بدليل هذا التذييل في آخر الآية ” أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ” .
فيبين الله سبحانه وتعالى أنه ليست العبرة أن يولي الناس وجوههم صوب المشرق أو المغرب، وإنما العبرة بما يرسخ في النفس من إيمان، وما يصدر من هذا العبد من امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فحينما يُؤمر أن يتجه إلى بيت المقدس توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى بيت المقدس، وحينما أُمر بأن يحول قبلته عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فعلوا ذلك امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى لا تقديسا لجهة دون أخرى، وإنما لحكم وأسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويستشف منها صدق إيمان المؤمنين، وحسن امتثالهم لله عز وجل، لذلك كانت الآية تبين على أن غاية البر هو ذلك العمل الصادق الذي يتجلى فيه امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، الذي يكون ناشئا من عقيدة راسخة، عقيدة الإيمان بالله ، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، مع اقتران ذلك كله بالخُلق القويم الذي هدى إليه هذا الدين.
ويمكن أن يُنظر إلى موضوع البر من خلال هذه الآية الكريمة من طريق أخرى وهي كيف أن هذه الآية بينت خصالا تتعلق بالأفراد، أي ما يطلب من الفرد وما يُطلب من الجماعة، وكلها دائرة تحت مظلة البر، فهناك من الإيمانيات ما هو مطلوب من كل فرد، وهناك أمور المواساة بالمال، حتى أصناف من يواسَون في هذه الآية أصناف قُصِد منها تحقيق غايات اجتماعية معينة، حينما يتأمل التالي لكتاب الله عز وجل ( ذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، والسائلين) .
على أن جمهور المفسرين يرى أن إيتاء المال المقصود في هذه الآية هو غير الزكاة، بدليل أن الزكاة عُطفت لاحقا على هذه الخصلة ” وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ”، ويستدل أيضا كثير من أهل العلم بحديث: ” إن في المال حقاً سوى الزكاة” والآية هذه أصلح في إعطاء هذا المعنى، لكن عموما الآية يمكن أن تمثل جماع الفضائل الفردية، والاجتماعية التي يترتب عليها صلاح الأفراد والجماعات، وبالتالي صلاح الأمة بأسرها في العقيدة، وفي العمل ، وفي الأخلاق.
*******************************
مقدم البرنامج: نلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل ذكر إيتاء المال كخصلة من خصال البر مباشرة عقب العقيدة، فما هي دلائل ذلك؟
الشيخ كهلان: هذا لأهمية هذه الخصلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي إيتاء المال في الجهات التي أباح الله سبحانه وتعالى أن يُؤدى إليها المال، ويُؤكد هذا المعنى آية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: “لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ” وهذه الآية صريحة في الدلالة على أن بلوغ غاية البر، أو الدرجة الأكمل منه لا تتحقق إلا بإنفاق المال في السبل التي أباحها الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنفاق الذي يُوصل إلى درجة البر لا يكون من المال الذي لا يحبه الإنسان، بل هو من أخص المال الذي يحبه “مِمَّا تُحِبُّونَ” كما في آية ( آل عمران:92 ) “لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ”، وحديث أبي طلحة الشهير حينما نزلت هذه الآية الكريمة، وكان له مال اسمه بيرَحاء، أو بيرُحاء، فبادر إلى التصدق بهذا المال، وأتى النبي- صلى الله عليه وسلم-، والرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يعرف هذه المزرعة التي كانت لأبي طلحة، لأنه كان يدخل فيها، ويشرب من مائها، ويأكل من ثمارها، فإذا بأبي طلحة يقول: إن أحب مالي إليَّ بيرحاء، وإني أضعها حيث شئت يا رسول الله، فإذا بالنبي- صلى الله عليه وسلم- يستبشر بهذا الإقبال على الخير من أحد صحابته الكرام- رضوان الله عليهم- ثم ينصحه أن يجعلها في قرابته، وقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ” بخٍ، بخٍ، ذلك مال رائح يروح بصاحبه إلى الجنة”.
فإذن: الإنفاق في سبيل الله له أهمية كبيرة، إيتاء المال في هذه الجهات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى له منزلة عظيمة، وهذه المنزلة نفهم منها بعض الأسرار.
أولا: ما تحققه للمجتمع من مواساة، وبالتالي من استلال للأحقاد والحسد، وكل آفات القلب التي يمكن أن تؤدي إليها الطبقية، وتكدس الثروة في أيدي بعض الناس في المجتمع دون بعض، كل هذه الآفات تختفي بسبب ذلك.
لكن مع ذلك هناك أبعاد أخرى يمكن أن نستشفها من آيات أخرى، كالآيات التي وردت في أواخر سورة البقرة، حينما نجد أن آيات الإنفاق تتوالى، والله سبحانه وتعالى في كل سياق يقول: “ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ “.
وفي بعض الآيات يقول سبحانه:” يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا” يأتي هذا في نفس السياق الذي يحث الله تعالى فيه عباده على الإنفاق، وإيتاء المال للفقراء، والمساكين، والمحتاجين بأصنافهم المختلفة، فلذلك يتبوأ إنفاق المال منزلة رفيعة، وينبغي للناس أن يتنبهوا لذلك.
هذا السياق-كما قلت سابقا-كلمة “على حبه” فيها دعوة للناس إلى أن يهذبوا نفوسهم بإخراج أموالهم إلى المستحقين في المجتمع، في ذلك تزكية للنفوس، وفي ذلك تزكية للأموال نفسها، فضلاً عما ذكرته من الآثار الظاهرة التي نجدها في إنفاق المال في هذه الوجوه، فالإنفاق من شيء تحبه النفس وترغب فيه هي درجة رفيعة من درجات البر لمن تأتى له ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، وهنا ملحظ وهو كون الإنفاق في سبيل الله ذُكر عقب الإيمان مباشرة، حتى يكون مقصوداً به وجه الله سبحانه وتعالى.
*****************************
مقدم البرنامج: يقع بعض الناس في حيرة من أمرهم حول فهم تعاليم الدين، فهناك تعاليم تتعلق بأعمال ظاهرة يقومون بها، وهناك حسن الباطن، وسلامة السريرة، فمن الناس من يحصر الدين في جانب من هذه الجوانب، ويرى بأنه الأهم والأولى بالعناية، فما هو الفهم الصحيح لهذه القضية؟
الشيخ كهلان: هذه القضية غاية في الأهمية، والناس فيها بين إفراط ، وتفريط للأسف الشديد، وهذا حاصل ليس على مستوى العامة فقط، بل حتى في أوساط المتعلمين، إن لم يكن يصل الأمر إلى حد أهل العلم الشرعي، وخلاصة سبب هذه الظاهرة التي نتحدث عنها هو أن من الناس من يسلط نظره صوب الأعمال الظاهرة فقط، وبالتالي يحسب أن البر والإحسان- البر للنفس- بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى الآخرين إنما يكون بالوقوف عند مظاهر ما افترضه الله سبحانه وتعالى من المأمورات والمنهيات، ويهمل في حقيقة الأمر في جوانب إصلاح الباطن، وتنقية الضمير، وتزكية النفس من داخلها، وبالتالي تكون أعماله في ظاهرها لا ريب أفعال صلاح، واستقامة، والتزام بأوامر الله عز وجل، لكنها نظراً لفقدانها لحقيقتها التي تنبعث من جوهر هذا الإنسان، من جوهر هذا الفاعل المتحرك الذي يأتي ما افترضه الله تعالى، وينتهي عما نهاه، فيكون في الغالب إيغال في هذا الجانب على حساب تزكية هذه النفس، وتنقية هذا الضمير، ويهمل ذلك الأساس الذي ينبغي أن تتجاوب معه حركة الجوارح.
في المقابل نجد أن من الناس أيضا من يُغرق ويبالغ ويسلط نظره صوب جانب الباطن، فيتعلق بطقوس معينة يحسب أنها تؤدي إلى تزكية النفس، وتنقية القلب والضمير والوجدان، والارتقاء بها، فإذا به يهمل ويقصر في الواجبات التي تتعلق بالجوارح بدنية كانت، أو مالية، أو حتى علمية فكرية، ولا هذا ولا ذاك هو من روح حقيقة الإسلام، بل الواجب أن يعي الناس كما نصت هذه الآية، وكما نجد أيضا في آية أخرى من ( سورة البقرة: 189 ) وهي قوله تعالى ” يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” هذه الآية الكريمة من سورة البقرة تتحدث عن فعل ظاهر كان يفعله أهل الجاهلية، قيل: ماعدا قريش– الحمس-ما كانوا يفعلون ذلك، لكن كانوا في الجاهلية يعدون أن من التقوى أنه إذا فرغ الناس من آداء المناسك أن يرجعوا إلى بيوتهم فلا يدخلوا من أبوابها، ولكن يقتحمون الأسوار، وقريش ومنهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ما كانوا يفعلون ذلك، فسأل أحد الصحابة – رضوان الله تعالى عليهم -، رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن هذا التصرف الذي لم يكن موجودا في أهل قريش، حتى أن بعض الروايات فيها أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ” أنا من الحمس” أو ” أنا من قريش” أي لا نفعل هذا الشيء ونزلت هذه الآية.
وسبحان الله، السؤال هنا عن شيء ظاهر، وهو إتيان البيوت من ظهورها، ويأتي الجواب ” وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى” ثم بعد ذلك “وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا” كان مقتضى الحال في غير القرآن الكريم أن يكون الجواب” ولكن البر أن تأتوا البيوت من أبوابها” لكن الله سبحانه وتعالى يبين أن إتيان البيوت من أبوابها الذي هو الفعل الشرعي المقبول إنما هو أثر لشيء ينبع من القلب وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، وعبَّر عن هذا التصرف بالبر” وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى” ثم قال: “وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا” وكرر الأمر بالتقوى “وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”.
الآية الأخرى أيضا في سورة آل عمران التي ذكرتها قبل “لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ” هنا إنفاق، والإنفاق فعل مالي، إنما يُبلِّغ هذا الإنفاق درجة التقوى حينما ينفق هذا العبد مما يحب، مع ما جُبلت عليه النفوس من الشح بالمال ، والرغبة فيه، ولكن تأتي هذه الآية لكي تُوقظ ضمير هذا الإنسان، فإذا به يُنفق هذا المال في وجوهه التي أمر الله سبحانه وتعالى بها.
وكما قالت الآية: ” وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ”.
فلذلك كان من الأهمية بمكان أن يعي الناس أن الأفعال الظاهرة – إن صحت التسمية بأنها أفعال ظاهرة- أو لنقل أفعال الجوارح من أقوال وأفعال، من أعمال يقوم بها الإنسان سواء كانت أفعال يقوم بها، أو منهيات يتركها- يُؤمر أن لا يفعلها – ينبغي أن تنبع من سريرة نقية صافية مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، راغبة في ثوابه، طامحة في نيل الأجر، راهبة خائفة من أن يصيبها عذاب الله سبحانه وتعالى.
وهذه السريرة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى أن تُحمل على البر والتقوى، والإحسان إلى الناس، ولكن دونما مبالغة، لأن بعض الناس أيضا يبالغ، ويلجأ إلى طقوس معينة، وإلى أذكار يرددها، وأوراد يتلوها تكون على حساب الفرائض، على حساب ما أُمر به، على حساب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكأنها تكون غاية يُراد أن يصل إليها في ذاتها، ولا يراد منها تنقية هذه النفس لكي تكون أكثر إيمانا، وأكثر يقينا، وأكثر قرباً من الله سبحانه وتعالى.
ونجد شواهد كثيرة في سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حينما يذكر له بعض الناس الذين يصلون، ويصومون، ويزكون ولكنهم يؤذون جيرانهم، أو يسيئون في أخلاقهم، ويسيئون في معاملتهم للآخرين، يسيئون حتى إلى بهائم عجماوات، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يبين أن ذلك ليس من الإيمان، ليس من البر، ليس من العمل الصالح، ليس مما يدخل الجنة.
إذاً لا بد أن يعي المرء أن عليه أن يصطحب معه روح البر، والإحسان، ومراقبة الله تعالى، وحفظ حقوقه، وحقوق الآدميين في كل أحواله، فيما يتعلق بتصرفاته الظاهرة التي تنبع من الجوارح، أو تلك التي تتعلق بسريرته ونقائها، وصفائها، ويقضة الضمير التي ينبغي له أن يوليها العناية الفائقة.
*********************************
مقدم البرنامج: عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن شيء قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
” البر حسن الخُلق، والإثم ماحاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس”.
قد ذكرتم أن البر يشمل الأعمال الظاهرة، والأعمال الباطنة، وما يتعلق بحسن الأخلاق والسيرة، فإن هذا الحديث نقلنا إلى المعنى الباطن، والأخلاق الطيبة.
الشيخ كهلان: هذا الحديث الذي استمعنا إليه قبل قليل وهو قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” البر حسن الخُلق، والإثم ماحاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس” حديث واضح الدلالة، ” البر حسن الخُلق” وما أجمل أن يعي الناس هذا المعنى الجديد للبر، أو هذا المعنى الصحيح للبر، فحسن الخُلق ليس هو من الفواضل في هذا الدين، ولا ميزان حسن الخُلق يكون من الأمور التي تعود إلى عادات الناس وطباعهم وما يريدونه لأنفسهم، وإنما هي موازين من عند الله سبحانه وتعالى لأنها داخلة في دائرة الثواب والعقاب.
وكم من آية قرآنية نصت نصا صريحا على أنواع من الخصال الكريمة، والأخلاق النبيلة التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون جميعا، وبالتالي فحينما يكون المعنى الذي يبينه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويبين فيه أن كل عمل يقبله الله سبحانه وتعالى ، ويُرضاه ربنا تبارك وتعالى إنما هو من البر، لأن هذا السائل سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن البر والإثم، لننظر في المقابلة التي عقدها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديثه عن البر والإثم، وجعل البر في مقابله الإثم، ولم يقل الأجر والإثم، أو الثواب والإثم، وإنما قال البر والإثم، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يبني الجواب على هذا الأساس، فيُعرّف له البر، ويُعرّف له الإثم، فالبر حسن الخُلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس.
وعلى هذا يدخل في مفهوم البر ما نصت عليه الآية الكريمة التي استمعنا لها في الفاصل الأول، وهي آية سورة البقرة “لَيْسَ الْبِرَّ…” بما فيها من فرائض، ومن أوامر، ومن نواهٍ، وبما فيها من عقائد، ومن إيمانيات، وما فيها من خصال خُلقية خُصت بالذكر وهي: الوفاء بالعهد، والصبر، والصدق.
وكثيراً ما يجد الناس في أنفسهم تصرفات لا يعرفون حكمها، فلو وزنوها بهذا الميزان: هل هذا التصرف هو من حسن الخلق؟ والعادة أن حسن الخلق يرغب المرء أن يطلع عليه الآخرون، أي لا يجد غضاضة من أن يطلع عليه الآخرون حينما تكون الفطرة سليمة، أما إذا كان هذا التصرف يجد المرء في نفسه أنه لا يريد أن يراه فيه الآخرون، وتجده يورثه ريبة وشكاً في خفايا نفسه فإن هذا أقرب إلى أن يكون من الإثم، ولو كان هذا الفرد غير فقيه ولا عالم.
لكن كلنا يجد مثل هذا الشعور في بعض التصرفات التي قد لا يتضح له حكمها ابتداءً، فلذلك يبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاعدة فعلاً جميلة وهي: أن ما كان من خصال هذا الدين موافقا لها، وجاريا على سننها إنما يكون مما لا يجد المرء غضاضة في أن يظهره للآخرين، في ذات الوقت هو يريد أن يستر عملا ما لأنه من أعمال البر التي يريد أن يدخر ثوابها عند الله تعالى: كالصدقة غير الواجبة في السر كما في حديث ” ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شماله حتى لا تعرف شماله ما أنفقت يمينه” فنحن لا نتحدث عن هذا، وإنما نتحدث عن ذات التصرف، نتحدث عن التصرف في ذاته، في أصله.
وفي مقابل ذلك فإن علامة ما يتنافى مع البر ما يجد المرء في نفسه منه ريبة، ولا يحب أن يطلع عليه الآخرون.
لنأخذ مثالاً حتى من الأعمال الواضحة الجلية التي يعرفها الناس، فكلمة البر تتصل عند كثير من الناس بالبر بالوالدين، فلو كان المرء باراً فإنه لا يجد غضاضة في أن يرى الناس أنه باراً بأبيه، وأنه يعين والده ، أو يعين أمه، وأنه يدعو لهما، وأنه يقوم بشؤونهما، والعكس أيضا كذلك فإنه يتردد، ويجد في نفسه شكاً، ولا يريد أن يطلع عليه الآخرون إن كان عاقا لوالديه.
إذاً: هذا هو المعنى الذي نجده في الحديث الشريف.
مقدم البرنامج: ماقصة حديث وابصة الذي ذكر فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ موضوع استفتاء النفس؟
الشيخ كهلان: حديث “ماحاك في نفسك” هو نفسه الذي نجده هنا في حديث وابصة” استفتِ قلبك يا وابصة وإن أفتوك، وأفتوك” وهذه الأحاديث تُفهم أيضا في ضوء حديث النعمان بن بشير الذي فيه بيان الحلال والحرام ” الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام…” ولذلك قال علماؤنا: إن القاعدة الجليلة ( أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيّه فاجتنبه، وأمر أُشكل عليك أمره فقف عنه) أي حتى تعلم حكمه، فالواقع في الشبهات واقع في الحرام كما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا ريب أننا نتحدث عن من كان ذا فطرة سليمة، تهتدي بنور الوحي، وبالعقل السليم، ولا يُقصد بذلك من يُخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى أهل العلم المعروفين بالورع والتقوى، فيستفتي فيُفتى بحكم شرعي، ثم يقول: لا أنا أستفتي قلبي وإن أفتوني هؤلاء وأفتوني، فليس هذا هو المقصود.
**********************************
سؤال متصل: نرى بعض الناس تهتم بالبر والإحسان إلى الآخرين، لكن تهمل نفسها، فهناك بر يتعلق بنفس الإنسان، فحدثنا عن هذا الموضوع، وجوانبه.
الشيخ كهلان: النفس قد يصيبها الملل، وقد تصيبها السآمة حينما لا تستريح بالترويح الذي أتى به الشرع الحنيف، فإن النفوس بحاجة إلى ترويح، ولكن ترويحها إنما يكون في دائرة المباحات، وفي ذلك أدلة كثيرة من أحاديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كحديث حنظلة الشهير حينما ختم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحديث بقوله ” ولكن ساعة وساعة”.
فساعة تكون في الذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وساعة تكون في الإقبال على ما تحتاجه الدنيا من عمارة، ومن تكاليف الحياة.
أيضاً حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا…” وبعض الروايات فيها أثر من ذلك حتى أنها عددت بعض الجوارح، وفي هذا السياق ينبغي فعلا للمسلم أن يُعطي لنفسه حقوقها، لأنها حينما يتعبها في البر بالآخرين، والإحسان إليهم، ويكون ذلك على حساب النفس، فإن هذا لا يتأتى لكل الناس، ولا يستطيعه أغلب الناس، هذا العطاء الذي يكون بلا حدود لا يتأتى بعد الأنبياء والمرسلين إلا لمن وفقه الله لبلوغ هذه الدرجة، لكن أغلب الناس، وفي عموم أحوالهم لا يستطيعون ذلك، وبالتالي يحتاجون فعلاً إلى أن يُروحوا عن قلوبهم، ويُجددوا همتهم ونشاطهم، لأن ذلك أيضا يعينهم على مواصلة طريق العطاء والبر، والإحسان ، لكن لا يكون أيضا هذا شغله الشاغل.
سؤال متصل آخر: الكل يعلم بأن الصدقات والإحسان ، والبر من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فما نصيحة الشيخ للذين ينفقون أموالهم في التفاخر والترف، كشراء أرقام السيارات المميزة بمئات الآلاف، وهناك من الفقراء من لا يجد ما يأكله؟
الشيخ كهلان: هذا ملحظ غاية في الأهمية، ويوجد ما يدعمه من حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من تعليق الإثم والوزر على من بات شبعان وجاره جوعان، فإنْ يصل الحال إلى حد المبالغة في الإسراف في أمور لا تغير شيئا في حقيقة حياة هذا الإنسان، ولا تضفي عليه شيئا، ليست هي حتى من الكماليات، حينما يُنظر إليها بالنظر الصحيح فإن هذا في الحقيقة يخل في ترتيب الأولويات عند هذا الإنسان.
فحينما نجد إخوانا لنا يعانون من المشكلات العديدة، ويمكن لنا أن نمد لهم يد العون والمساعدة فلا ينبغي للمسلم أن يتمرغ في الترف والإسراف، ويرى شرائح من أبناء مجتمعه، ومن إخوانه بحاجة إلى شيء يسير، لا يتصور هو ما يمكن أن يحققه لهم ذلك الشيء اليسير.
وكم دعا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أن لا يحقر المرء ولو شيئا يسيرا يدفعه إلى محتاج أو فقير، أو مسكين، ولذلك ينبغي للأفراد، وينبغي للمجتمعات أن تتنبه بأن الاستمرار في الإغراق في هذا الترف والإسراف يؤدي إلى نتائج سلبية على عموم المجتمع.
فالمسألة ليست مسألة هينة، وهذا الطبع منافٍ تماما لحقيقة البر.
لا مانع من أن يستمتع المرء بالمباحات، وأن يقوم بالواجبات، وأن يكون ذا مال، كما يقول أحد العلماء: نحتاج إلى زهد أبي بكر ، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، كانوا أثرياء أغنياء، ولكنهم كانوا ينفقون في سبيل الله بشتى أنواع الإنفاق.
وباختصار نقول: إن الإنفاق مشروط أن يكون في محله، بحيث لا يكون على حساب الواجبات، وعلى حساب حاجات الأمة من تنمية، وإصلاح، وسد لحاجات الفقراء والمساكين، فلو أن من كان حاله من اليسر والغنى يمكنه من أن ينفق ويغطي هذه الحاجات فإنه يكون قد أدى ما عليه لله تعالى، وتبقى مسألة الإنفاق، ومتى يبلغ حد التبذير، لأنه يختلف من شخص إلى آخر بحسب غناه، وبحسب نفقاته.
وعموماً فإنه يُطلب من الإنسان أن يعتدل في الإنفاق، لأنه ليس من البر أن يكون إنفاقه في كماليات لا تسمن ولا تُغني عند الله سبحانه وتعالى على حساب حاجات ضرورية للمجتمع، ولا يقدم شيئا للآخرة.
فإن كان الإنسان ذا يسر ومال فليتجه إلى الوقف الخيري بعد أن يؤدي الزكاة والصدقات، فبإمكانه أن يوقف شيئا على الأعمال التي يعود نفعها لصالح المجتمع، أو أن يعين ذا حرفة أو صنعة.
*****************************
مقدم البرنامج: إلى أي درجة يكون البر من المسلمين إلى غيرهم ممن يختلفون عنهم في الدين؟
الشيخ كهلان: الجواب على هذا السؤال جاء في قوله تعالى من سورة الممتحنة ” لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” فاستُخدم فعل البر صراحة في هذه الآية مقرونا بالقسط ” لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” في هذه الآية الكريمة نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين أن من لم يعادِ المسلمين في الدين، ولم يقم بما يؤدي إلى إخراجهم من ديارهم حساً أو معنى، أي لم يشارك في ظلم المسلمين،ولم يهن لهم دينهم، فإن الله تعالى يأمر بالبر بهم، وبمعاملتهم بالقسط.
ومما يروى في نزول هذه الآية أن قُتيلة أم أسماء بنت أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ كانت مشركة، فلما نزلت هذه الآية زارت قُتيلة بنتها أسماء في المدينة المنورة، فامتنعت أسماء بدايةً من بِرِّها، حتى سألت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هل تصل أمها أم لا، فقال لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : “نعم صلي أمك”.
ولا تقتصر دلالة الآية على هذه، فهي ليست سببا للنزول بل سببا للشمول، أي أن الآية تشملها كما تشمل غيرها، ولا يتعلق الأمر بالوالدين فقط، فهناك أصناف أخرى كانوا حلفاء للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهم من المشركين مثل: خزاعة، وبني حارث بن كعب، ومزينة، وقيل: إن الآية أيضا تشملهم.
فإذاً: هكذا كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعامل المشركين، فكيف بغيرهم من أهل الكتاب، طالما أنهم لم يتعرضوا لهذا الدين بالإهانة، ولم يؤذوا المسلمين، ولم يناصروا على إيذائهم، وعلى ظلمهم فالأصل في العلاقة أن تكون مبنية على البر وعلى القسط والعدل، هذا هو الأصل في العلاقة التي تكون بين المسلم وغيره، أما حينما تكون هناك إساءة من الآخر إلى المسلمين فإنه يُتعامل مع هذه الإساءة بحسبها، لكن القاعدة الأصلية في التعامل إنما هي قاعدة البر، والقسط، والأمثلة في التاريخ على ذلك كثيرة جدا.
*******************************
خاتمـــة الحلـــقة
مقدم البرنامج: هذا البر الذي سلكه المسلمون مع غيرهم ترك آثاراً طيبة عند الآخرين، ورأوا بأنهم كانوا بالفعل غزاة تمدُّنٍ وليسوا غزاة فتح، كما عبر هذا الكاتب في المقولة التالية:
وصف المفكر الأسباني الكبير ( بلاسكو أبانيز ) في كتابه ” ظلال الكنيسة” العهد الإسلامي في أسبانيا، وهو كاتب غير مسلم فقال:
“لقد أحسنت أسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين قدموا إليها من القارة الأفريقية، وأسلمتهم القرى أزّمتها بغير مقاومة ولا عداء، فما هو إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى حتى تفتح لها الأبواب، وتتلقاها بالترحاب، وكانت غزوة تمدن، ولم تكن غزوة فتح وقهر، وفي خلال سنتين اثنتين استولى الغزاة على مُلكٍ قضى مستردوه سبعة قرون كاملة في استرداده، ولم يكن في الواقع فتحا فُرض على الناس برهبة السلاح، بل حضارة جديدة بسطت شعابها على جميع مرافق الحياة، ولم يتخلَ أبناء تلك الحضارة زمنا عن فضيلة حرية الضمير، وهي الدعامة التي تقوم عليها كل عظمةٍ حقةٍ للشعوب، فقبلوا في المدن التي ملكوها كنائس النصارى، وبيع اليهود، ولم يخش المسجد معابد الأديان التي سبقته، فعرف لها حقها، واستقر إلى جانبها غير حاسدٍ لها، ولا راغبٍ في السيادة عليها، ونمت على ذلك ما بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر أجمل الحضارات ، وأغناها في القرون الوسطى، وفي الزمن الذي كانت فيه أمم الشمال فريسة للفتن الدينية، والمعارك الهمجية، يعيشون عيشة القبائل المتوحشة في بلادهم المتخلفة كان سكان أسبانيا يزدادون فيزيدون على ثلاثين مليونا، تنسجم بينهم جميع العناصر البشرية ، والعقائد الدينية”.
انتهت الحلقة