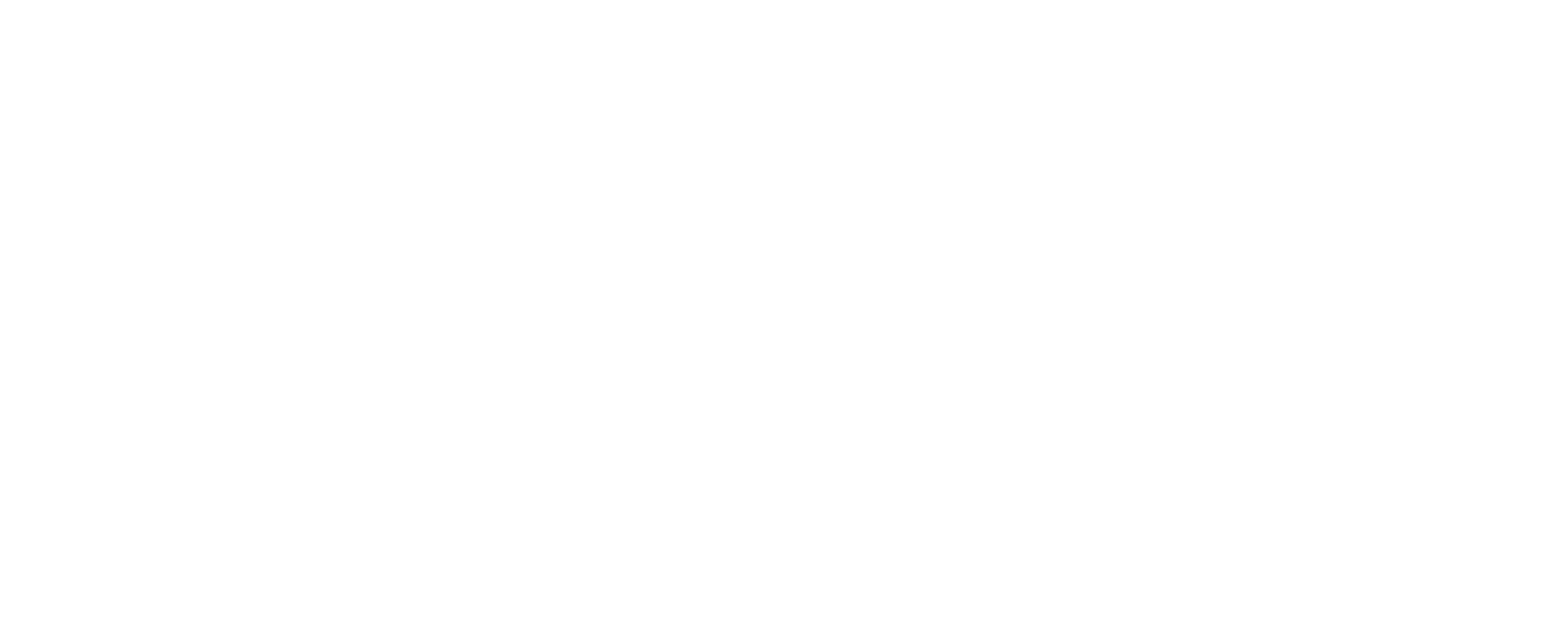الإعجاز البياني في القرآن الكريم للشيخ الخليلي
( من ضمن دروس العقيدة التي ألقاها سماحته في جامعة السلطان قابوس، وهي تحمل بين دفتيها علماً غزيراً )
—————————————————
افتتاحية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، أحمده وأستعينه وأستهديه ، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعــد :
تآخي الكلمات إعجاز:
فإن عنوان هذا الدرس هو الإعجاز البياني في كتاب الله الذي يثبت أي من جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رسول من عند الله رب العالمين الذي أيده بهذه المعجزة الخالدة ، وفي الدرس السابق تحدثنا عن أمثلة من إعجاز القرآن الكريم البياني ،
وأن هذا الإعجاز يشع من ألفاظ القرآن الكريم ومعانيها معاً،
وذكرت بأن من إعجاز ألفاظه ذلكم التناسق العجيب الذي بين كلمات الجملة الواحدة ، وحروف الكلمة الواحدة والجملة المترابطة في السورة الواحدة ، كما ذكرت ان هذا الإعجاز يتجلى فيما يجليه القرآن الكريم من أحوال نفسية ومشاهد غائبة وصور عقلية فتكون كالأشباح التي تتراءى بين يدي سامع القرآن الكريم أو تاليه وأمام ناظريه ،
وذكرت فيما ذكرت بأن الكلمات إنما يشع إعجازها من حيث ذلك التآخي بينها حتى تكون كل واحدة منها آخذة عن واحدة أخرى ، ومع ذلك فإن المعاني تتساوق مع هذه الكلمات وهي متآخية كتآخي الكلمات الدالة عليها ، وإيحاءات الحروف أيضاً لها أثر بارز في هذا الإعجاز ، فإن الحروف التي في الكلمة الواحدة كالكلمات المتجاورة وتناسقها تناسقاً عجيباً من حيث المخارج ، ومن حيث صفات هذه الحروف من الجهر والهمس والرخو والشدة إلى غير ذلك من الصفات ، ولكن حرف من الحروف له هذه الصفات ، ومع تلائمها وترابطها ،
وأعود إلى بعض الأمثلة التي لم أذكرها في المرة الماضية ، الله سبحانه وتعالى يقول : (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (التكوير:18) :
في هذه الآية الكريمة كلمات ثلاث وهي : الصبح وتنفس وإذا التي تربط ما بينهما لو جيء بكلمة أخرى تربط مع كلمة الصبح هنا ما سدت مسدها ، فإن التآخي الحاصل ما بين كلمتي الصبح وتنفس تآخٍ عجيب ، ما هي الكلمة التي يحتمل أن تنوب مناب الصبح هي كلمة الفجر ، لكنها لو وضعت مكان الصبح هنا لما سدت مسد هذه الكلمة ، ذلك لأن الصبح من الإصباح ، والفجر من الانفجار ، فالفجر هو عبارة عن انفجار أول ضوء من سواد الليل البهيم ، والصبح هو عبارة عن الإصباح وسريان هذا الضوء في الفضاء ، كما تسري الروح في الجسم وكما يسري الماء في الشجر ، وذلك أن تمتد أسنة الضوء فتمزق رداء الظلام الذي يكلل الفضاء في هذه الحالة ، عندما يسري الضوء في الفضاء تسري الحياة من جديد إلى الأرض التي يسري فيها هذا الضوء فتأخذ الأزهار وأوراق الشجر هذا الضياء ، كما يتلقى المحب حبيبه ، وتبتهج النفوس ، وكل أحد يدرك كيف تكون الفرحة التي تملأ النفس عندما يقبل الإصباح ، ويرى الإنسان ضياء الصبح بعينه ، والنفس تنشرح هذا الانشراح ليس خاصاً بالجنس البشري ، بل تبتهج له الكائنات المختلفة ، ولذلك نسمع الطيور تغرد في ذلك الوقت ، وتتجلى الحياة في واقع الناس، فالناس ينطلقون في البحث عن أرزاقهم .
هذه العبارة هي التي تلائم كلمة التنفس لأن تنفَّس معناه جر النفس ودفعه ، وإن دلت على دفع النفس ولكن لابد أن يسبقه استجرار هذا النفس في استجرار الهواء داخل نفس الإنسان هو الذي يجعل الحياة تسري في هذه النفس الهواء لما كانت حياه ، كما أن نفع هذا النفس إنما هو دليل وجود هذه الحياة، فمن انقطع نفسه انقطعت حياته ، فالتآخي بين هاتين الكلمتين لا يوجد له نظير لو بدلت إحداهما بكلمة أخرى ، فلو وضعت بدل كلمة تنفس كلمة أخرى لما سدت مسدها، ولو وضعت بدل كلمة الصبح كلمة أخرى لما سدت مسد كلمة الصبح .
ولقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم وصفاً عجيباً في قوله لرسوله عليه الصلاة والسلام (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (الشورى:52) هذه الآية الكريمة مسبوقة بقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ) (الشورى:51) في الآية السابقة تحديد وتكليم الله تعالى البشر، فإن الله عز وجل لا يكلم أحداً من البشر إلا وحياً أو من وراء حجاب، فالوحي يشمل الصوت الذي يسمعه السامع من غير أن يعرف مصدره، كلمة الوحي فيه شيء من معنى الخفاء، “فأوحى إليها الطرف أني أحبها” فأثر ذاك الوحي في وجناتها.
بعدما بين الله سبحانه وتعالى أن الوحي لا يكون إلا من وراء حجاب خاطب الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الإلهي فكان وحياً من قبل الله ، والوحي يتلاءم مع ذكر الروح ، فإن الوحي مشعر بالخفاء والروح أيضاً من العوالم الخفية ، فإن الروح سر، فالقرآن روح من أمر الله سبحانه؛ لأن القرآن الكريم لا يمكن لأحد أن يحيط بأسراره والروح التي جعلها الله سبباً لحياة الإنسان لا يحيط أحد بها (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي )(الإسراء: من الآية85) والقرآن الكريم تحيا به النفوس كما تحيا الأجساد بالأرواح ، (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا )(الأنعام: من الآية122) ثم بين أن هـذه الروح الموحى بها من أمر الله فلا سلطان لأحد على القرآن الكريم ، لا يستطيع الشياطين أن تجيء به وتلبس بـه الناس ، حتى يخلص اليقين في نفوس الناس بأن القرآن من عند الله لم يكن ذلك من تأثير الشياطين على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ، كلا والله ، وإنما هو روح من عند الله.
ثم بين وضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي إليه ، فلم يكن النبي من قبله على علم بالكتاب ، ولم يكن يقرأ ولا يكتب ، وإنما فوجئ بهذا الوحي من عند الله تعالى ، ولم يكن يعرف تفاصيل الإيمان ، وإن كان عليه الصلاة والسلام راسخ الإيمان منذ صغره ، ثم قال ” وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً ” حيث شبه الهداية المعنوية بالهداية الحسية التي تكون من النور الحسي ، ولا ريب أن الفارق بين الموت والحياة فارق شاسع ، فما دام أن القرآن روح لابد وأن تكون معه هداية لأن الإنسان يهتدي بالروح ، فالميت لا حـراك له ، لا يشعر بشيء ، الحي مهما كانت ضلالته ولكنه يحس ، يعلم ، يتوصل إلى معرفة أشياء لا يمكن أن يعرفها فـي حالة موته ، والعلم نور ، والجهل ظلمة ، لأن الظلام يواري الحقائق المحسوسة ، والجهل يواري الحقائق المعنوية ، فإذن وصف القرآن بأنه نور يتلاءم مع وصفه بأنه روح (وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) يقتبس من هذا النور منَّ الله سبحانه وتعالى عليه بالتوفيق للاستضاءة به ، والاستنارة به ، ثم بين بعد ذلك وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية إلى صراط مستقيم ، هذه الهداية إنما بهذه الروح، يهذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، فالكلمات كلها متلائمة أخذ بعضها بحدة بعض .
* كلام الله صوت النَّفْس وصوت العقل وصوت الحس:
ومن الذين كتبوا حول الإعجاز القرآني البياني من المتأخرين الدكتور “مصطفى صادق الرافعــي” في كتابه ” إعجاز القرآن البياني ” وقد قسم الكلمات إلى ثلاثة أقسام : صوت النفس ، فهو موجود في كل كلمة لها معنى من المعاني ، في الكلمات المستعملة لا في الكلمات المهملة ، فإن الكلمات المستعملة توحي إلى النفوس إيحائها توحي إلى السامعين معانيها ، ثم صوت العقل ، وهو لا يكون إلا في الكلام البليغ الذي يلقيه المتحدث أو يكتبه الكاتب إلى موضع الإقناع من العقل ، والوجدان من القلب ، هذا صوت الحس ، وهو أن يصل الكلام إلى عمق النفس حتى يستولي على حواسها ، ويجعل هذه النفس لا تجد مخلصاً على الاستسلام والإذعان لتأثير هذا الكلام ، صوت الحس لا يكون في كلام البشر ، إلا في الكلمات النادرة القليلة ، إذا حصل في كلام البشر ، فإنه يحصل في كلمات نادرة قليلة قد تكون هذه الكلمات مثالاً تنطق بها الألسن ويسير بها الركبان ، ويتأثر بها الناس ، ويكون لها وقع كبير في النفوس ، ولكن تأثير الأمثال إنما يكون بمعرفة الوقائع والأحداث التي أطلقت من أجلها هذه الأمثال .
فإذن هذه الكلمات القصيرة من المثل إنما يتوقف تأثيرها في النفس على مراعاة الأحداث والوقائع التي قيلت فيها، بينما القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره يعبر عنه بصوت الحس لأنه يمتلك إحساس كل إنسان ، فالقرآن تحدث في موضوعات متعددة ، حيث إنه جاء آمراً وناهياً وواعداً ومتوعداً وقاصاً أخبار النبيين وشؤون الأمم ، وسنن الحياة ومبيناً للتشريع والأحكام ، ومبيناً الحِكم من الأوامر والنواهي، ومنبئاً عن أحوال اليوم الآخر ، إلى غير ذلك من الموضوعات التي طرقها القرآن الكريم .
وهو في جميع هذه الأحوال يستولي على شعاب النفس ويمتلك الوجدان من كل قلب ، وإنما كانت المكابرة ممن كانت منهم مكابرة للنبي صلى الله عليه وسلم ، كانت هذه المكابرة في حقيقتها للعقول وللإحساس ، فأولئك المشركون الذين أنكروا تأثير القرآن على أنفسهم ، وقالوا : (لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا )(الأنفال: من الآية31) إنما يكابرون عقولهم ويكابرون وجدانهم ويكابرون إحساسهم ، وقد وقر إعجاز القرآن الكريم في إحساسهم، وإنما كانت ألسنتهم تنطق بخلاف ما وقر في قلوبهم ، وقد وقفوا موقف الحيرة من القرآن ، فلم يستطيعوا أن يتحدوه كما قلت من قبل .
تُحدُّوا أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحدوا بأن يأتوا بمثل سور من مثله فعجزوا ، وتحدوا أن يأتوا بسوره من مثله فعجزوا ، لو حاولوا أن يأتوا بما تحدوا فمن أي باب يدخلون ، لو أنهم أرادوا أن يدخلوا من باب الألفاظ وينظروا إلى هذا الترابط العجيب والتناسق الغريب ما بين كلمات القرآن الكريم وتآخيها في الجمل ، وما بين الحروف وتآخيها في الكلام مع مراعاة نبراتها وإيحاءاتها المختلفة بحسب مخارجها وبحسب صفاتها ، ومع هذا كله فإن القرآن الكريم لم يرتب حسب الموضوعات ، فالقرآن يشمل على ضروب شتى المقاصد ، فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والأمثال والحكم والعظات ، ولكن لا نجد أوامره ونواهيه في باب ، ووعده ووعيده في باب أخر ، وقصصه في باب ، وأمثاله في باب ، ولا نجد أيضاً أوامره ونواهيه أيضاً مرتبة ترتيباً ، فلا نجد أحكام الصلاة في باب ، والزكاة والصيام وأحكامها في باب أخر ، وهكذا أحكام التشريعات المختلفة حسب أبوابها ، لا بل نجد القرآن الكريم بينما يأمر وينهي إذا به يعد ويتوعد ويأتي بالقصص والمثال ، ويأتي بالعظات المختلفة ، ويثير في النفوس شجوناً متنوعاً ، فإذن القرآن يختلف عن غيره من الكلام ومع ذلك كله فإن هذه الألفاظ متناسقة ، وهذه المعاني متناسقة ، حتى وإن اختلفت الألفاظ ، فإنها مع ذلك كله بدونها لا يفصل بعضها عن بعض ، وكيف يمكن ان يفصل بعض القرآن عن بعضه بعض ، وأما من حيث المعاني – جاءت الأدلة والمعاني – فقد جاءت الأدلة ناصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبعض الآيات القرآنية أفضل عن بعض .
* ومن حيث البلاغة
فإننا لا يمكن أن نفضل تعبيراً في القرآن الكريم عن تعبير آخر ، آيات التوحيد ، وآيات الوعد والوعيد ، وآيات القصص والأمثال والعظات ، هذه كلها جاءت في الذروة من البلاغة وتنحط دونها بلاغة أخرى من جميع البلغاء .
وهو من حيث التعبير نهر من النور ، كل حرف منه لمعة من النور ، ولو أزيل أي حرف منه عن موضعه ، فقد تلك الروح التي كانت فيه ، لو أزيل أي حرف من القرآن الكريم عن موضعه ووضع في كلام البشر فقد تلك الروح التي كانت تسري فيه ، وهو متناسق بحسب هذا التنظيم الإلهي العجيب في هذا الكتاب العزيز ، ومع اختلاف أهدافه وأغراضه ، وكما قلت لا تفاصيل بين عباراته .
وليس ذلك من شأن كلام البشر ، فإن كل أحد من البشر أوتي شيئاً من البلاغة ، نجد كلامه يتفاوت بين موضوع وآخر سواء كان شاعراً أو كاتباً أو خطيباً ، فالشعراء مثلاً لا يمكن لشاعر منهم أن يتفوق على جميع الشعراء في جميع أغراض الشعر ، والمديح والغزل والنسيب والحماس والرثاء ، وجميع أغراض الشعر فربما كان شاعر أبلغ من غيره في المديح ، وربما كان شاعر أبلغ من غيره في الحماس ، وربما شاعر أبلغ من غيره في الرثاء ، وهكذا تتفاوت مقامات الشعراء التي يطرقونها في كل أشعارهم ، ومع سمو مراتب البلغاء من الشعراء وغيرهم فإنه يوجد في كلامهم أحياناً الذي لو قيس بكلامهم البليغ -ما ينقد-، فامرؤ القيس مثلاً ، من شعراء العرب الأوليين الجاهليين يوجد في كلامه ما يمكن أن يلحظ عليه ويقال ، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفضل بعضه عن بعض في التعبير ، فيقال مثلاً هذه الآية أبلغ من هذه الآية أو هذه السورة أبلغ من هذه السورة مهما اختلفت الأغراض إنما هو كما قلت كنهر من النور كل حرف منه لمعة منه نور .
بلاغة لكل العصور وكل الفئات:
القرآن الكريم البياني اتساعه –على مرور-التطورات الإنسانية منذ أن نزل القرآن وإلى أن تقوم الساعة ، فإن البشر مروا بأطوار علمية وفكرية ، أطوار لا يستهان بها ولكن مع ذلك عبارات القرآن تتسع لهذه الأطوار كلها ، فنجد هذه العبارات تتلاءم مع أفكار الناس ، ومدارك عقولهم ومراتب علومهم من ناحية الحياة ، منذ نزل القرآن الكريم وحتى وقتنا هذا ، مع هذا القدر الذي لا يبلغ شأنه من البلاغة ، بينما كلام البشر بخلاف ذلك فإن الكلام كلما كان ابلغ كان أنص على المعنى، أدل على المراد ، وإنما الاحتمالات تكثر إذا كان الكلام ركيكاً لا يؤدي المعنى المطلوب؛ لأنه أبعد عن الوصول إلى الهدف ، وإيصال المعاني التي تراد به إلى العقول .
والقرآن الكريم مع هذا القدر من البلاغة يتسع لأطوار الدهر لأنه خطاب وجهه الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء البشر ، بمختلف أطوارهم وتنوع ثقافاتهم واختلاف مداركهم ، فالرجل البدوي الذي لم يكن يتصور أنه في يوم من الأيام ستكون مراصد فلكية ، أو ستكون مختبرات علمية ، إذا قرأ القرآن الكريم يجد أن هذه الآيات جاءت تخاطبه ، وتخاطب أمثاله ، وأن ما فيها ينطبق على العصر الذي هو فيه ، نفس الشيء العالم الفلكي مثلاً في وقتنا هذا أو الذي درس الأحياء ، أو درس أي ناحية من نواحي العلوم الحديثة وعنده المختبرات وعنده ، إذا رجع الى القرآن الكريم وجد أن هذه الآيات تخاطب ابن هذا العصر .
فلو جئنا مثلاً إلى قول الله سبحانه وتعالى (لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (يـس:40) هذا الرجل الذي كان يعيش في الصحراء الغربية يتصور من هذا الخطاب من المعاني ما يتلاءم مع إدراكه، ويرى أن هذا الخطاب ما قصد به إلا من يعيش في تلك البيئة العربية البدوية الصحراوية ، كذلك إذا تلا أو تُلى عليه قول الله سبحانه وتعالى (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً)(البقرة: من الآية22) وكان يتصور أن هذه الأرض منبسطة وأن السماء قبة من مادة كثيفة زرقاء مضروبة على هذه الأرض ، يتصور أن كون السماء بناء إنما هو ضرب من هذه القبة التي يراها بناظريه ، عالم الفلك في وقتنا هذا الذي درس طبيعة الكون ، ورصد حركة الأجرام الفلكية بالمراصد الأرضية الكبرى يرى أن هذه الآية جاءت لتخاطب عقله ، ويرى أنها منطبقة تمام الانطباق مع ما وصل إليه العلم الجديد من الترابط ما بين جميع الأجرام الفلكية بهذا الرباط العجيب ، وأمسك الله سبحانه وتعالى هذا الكون بأسره بما سنه فيها من هذا النظام ، حتى إذا شاء الله أن ينتهي الكون اختل هذا النظام بمشيئة الله وتباعدت الأجرام وانتهى الكون .
ويرى أيضاً أن نفس الغلاف الهوائي الذي يظل هذه الأرض من كل جانب ، يحيط بها من كل جانب والكتلة الهوائية نفسها بناء ، وهذا السقف يقي هذه الأرض ما يتقاذف من الشهب ، عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى (وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ)(الأنعام: من الآية125) يتصور أن هذا الضيق يكون في الصدر بسبب ارتفاعه إلى أعلى وما يصيبه من الإرهاق والإعياء، بينما رجل عصرنا هذا الذي درس طبيعة الهواء الذي يحيط بالأرض وما فيه من أكسجين ، وأن هذا الأكسجين يتضاعف فوق الأرض مباشرة ويقل كلما بعد الإنسان عن الأرض، عندما يتلو هذه الآية يفهم منها أنها جاءت لتخاطب أمثاله ، وأن المراد بقوله : (كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ) أن من صعد في طبقات الجو فقد الأكسجين وضاق صدره .
بلاغة فريدة متميزة:
فإذن هذا الشمول في تعبير القرآن الكريم ، هذا الشمول العجيب إنما هو دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى؛ بحيث يتسع لآفاق الفكر الإسلامي على اختلاف العصور وتطور الثقافات واختلاف الأفكار بين عصر وعصر .
وقد حاول أعداء الإسلام بشتى الوسائل أن يحطموا اللغة العربية الفصحى ، مرت فترة من الفترات كانت هناك محاولة من الذين هم من أبناء المسلمين لكنهم يعملون ضد الإسلام وضد المسلمين ، كانت محاولة بإيماء من الذين تلقوا منهم هذه التعليمات أن يزهدوا في الحروف العربية، وأن تكتب لغة القرآن ، لغة الضاد بالحروف اللاتينية، وقد عقدت من أجل ذلك مؤتمرات ، حتى أنه في أحد هذه المؤتمرات كان صراع ما بين شيخ أزهري وآخر من هذا النوع الذين يريدون كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية ، فسأل الشيخ الأزهري هذا الرجل: ما هو المبرر لهذه المحاولة؟ وما الداعي لكتابة هذه اللغة مع استقلالها بحروفها ؟ بالحروف اللاتينية ، ماذا تريد بأسلوب حكيم فيه مغالطة ، قال له: لا تريد أن تعممها ولكنك تريد أن تبرنطها ، وهذا هو الواقع يريد أن يلبسها البرنيطة لا أن يلبسها العمامة ، وهكذا كل المحاولات لإبعاد الناس عن اللغة العربية الفصحى إنما هي محاولة لصدهم عن ذكر الله وصدهم عن فهم مقاصد القرآن الكريم .
وبما أن هذه الأمة مسؤولة عن هذا الكتاب الذي أكرمها الله سبحانه وتعالى به، ولا يمكن أن تتلقى الهداية إلا به ، ولا يمكن أن تعرف حلالها من حرامها إلا به ، ولا يمكن أن تهدي إلى سواء السبيل إلا به ، ولا يمكن أن تصلح أمر دنياها فضلاً عن أمر دينها إلا به ، فعلى الجيل الناهض أن يحرص على تعلم اللغة العربية ، وأن يدرس إعجاز القرآن الكريم دراسة عميقة حتى يدرك تميز هذا القرآن عن سائر الكلام ، وعلى هذا الجيل الناهض أن يعتز بصلته بهذه اللغة التي شرفها الله عز وجل بأن جعلها وعاءً لكلامه العظيم ، وجعلها الله سبحانه وتعالى مصباً لهذا النور الإلهي، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق لكل ما فيه الخير ، ونفتح الآن باب السؤال والجواب حول ما دار في هذا الدرس .
* أسئلة حول الدرس ،
س1- يقول : ذكر الله تعالى في كتابه العزيز كثيراً من الآيات على لسان بعض خلقه ومنها ما ذكره عن إخوة يوسف لأبيهم ( تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ)(يوسف: من الآية85) فهل هذا التركيب بعينه جاء على ألسنتهم أم هو من عند الله سبحانه؟
ج- الله سبحانه وتعالى حكى في كتابه أقوال الناس على اختلاف لغاتهم ، فمنهم العبرانيون والسريانيون وغيرهم ، تحدثوا بلغات متعددة وبأساليب مختلفة ولكن مع ذلك جمع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بهذا الأسلوب البليغ وحتى العرب أنفسهم الذين حكى الله عنهم ما حكى ، إنما حكاه ما حكاه عنهم بأبلغ أسلوب ، فهذه العبارة ليست عبارة إخوة يوسف عليه السلام وما كانت لغتهم العربية، وإنما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ما قالوه في كتابه العزيز .
س2- السائل يسأل : عن قوله تعالى (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ)(يوسف: من الآية111) من الآيات الأخيرة من سورة يوسف ، يقول: أمثال هذه الآيات كثيرة في الكتاب العزيز ، هل يمكننا من هذه الآيات أن نفهم أن جميع العلوم سواء منها الإنسانية أو العلمية موجودة في القرآن الكريم ، سواء علمناها ام لم نعلمها ؟!
ج- القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليكون كتاباً علمياً يتناول جانب من جوانب العلوم علم الهندسة مثلاً أو علم الفلك ، أو علم الأحياء ، أو علم التاريخ ، ما جاء القرآن الكريم لأجل أن يعلم الناس هذه العلوم فإنها علوم تجريبية ، هذه العلوم : علم الطب ، علم الهندسة ، علم الفلك هذه علوم تتوقف على الدراسة ، القرآن وظيفته أخبر الله تعالى عنها بقوله” (هُدىً لِلنَّاسِ)(البقرة: من الآية185) هو هدى للناس جاء ليهدي هذه العقول الضالة الشاردة ويردها إلى بارئها ، ولكنه يخاطب الفطرة الإنسانية ، وبما أنه يخاطب الفطرة الإنسانية وهذه الفطرة ملتبسة بأحوال الكون فإنه معرض خطابه لهذه الفطرة يوقظها بهذه اللمسات التي يضعها على هذه العلوم المختلفة ، يضع هذه اللمسات ليوقظ هذه الفطرة ولا يعني ذلك أن القرآن الكريم علم الهندسة بدقائقه وجزيئاته ، ولا لأن يدرسنا علم الطب بدقائقه أو جزيئاته .
وقد جعل الله سبحانه وتعالى الكون بأسره مسرحاً لاعتبار الإنسان مسرحاً لنظره ، مسرحاً لتفكيره ولذلك يقيم الله سبحانه وتعالى على العبد حججه من خلال هذه الآيات الموجودة في نفسه والموجودة حوله ، أما كون القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء ، فلا يعني ذلك هذه الإحاطة الدقيقة التي قد يبالغ بعض الناس ويزعمون أن القرآن ينطوي عليها جميعا، ولكن فيه تفصيل كل شيء فيما يعني الإنسان ويحتاج إليه .
س3- السائل يسأل عن قول الله تعالى في قصة مريم (إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً)(مريم: من الآية18) ما المقصود بكلمة تقي في الآية ؟ وكيف يستعاذ بالرحمن ممن كان تقياً ؟! وما وجه الإعجاز البياني لورود كلمة تقي دون غيرها من الكلمات ؟!
ج3- كلمة تقي هنا تحتمل معنيين ، قيل: -وهذا مالم أجد دليلاً عليه ، قد يكون ذلك صحيحاً وقد يكون غير صحيح- بان جبريل عليه السلام جاءها في صورة شاب يسمى تقياً ، والقيل الآخر إن كنت تقياً إن كنت تخشى الله ، فإن الذي يخشى الله عز وجل إذا سمع هذه الاستعاذة تثور في نفسه مشاعر التقوى وعند ما يثور في نفسه مشاعر التقوى يكف عن عمله ، وفي هذا ما يكفي الإنسان دليلاً على أن هذه الكلمة وضعت موضعها ، ومفهوم كلمة التقوى مفهوم واسع ، فإنها وإن كانت في أصلها اللغوي الاجتناب والابتعاد ، اتقى مطابق وقعه وقيته أقيه فأتقاه ، أي جنبه أجنبه تجنبه ، لأن فاء الكلمة واو ، والفعل الذي فاؤه واو ، أو لام ، أو نون ، أو ميم ، أو راء ، يأتي مفاعله على مفتعل وفعل “افتعل قد يطاوع * وحيث تروى بفاء شائع” .
س4- ذكرتم أن الآيات القرآنية تتفاوت من حيث المعنى فهلا تفضلتم ببيان ذلك ؟!
ج- نعم ، القرآن الكريم اختلف العلماء في تفضيل بعضه على بعض، منهم من منع تفضيل شيء على شيء منه، وقال: لا يقال بأن سورة كذا أفضل من سورة كذا ، أو آية كذا أفضل من الآية كذا ، هذا رأي طائفة من العلماء ، هناك رأي طائفة أخرى يخالف هذا الرأي ، يقولون : إن القرآن الكريم يتفاضل بحسب الموضوعات التي يطرقها، فقول الله سبحانه وتعالى (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ)(آل عمران: من الآية18) وقوله تعالى (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ )(البقرة: من الآية255) وقوله تعالى (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ )(النور: من الآية35) طبعاً هذه الآيات أفضل من قوله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(البقرة: من الآية222) فإن الآيات الأولى تتحدث عن جلال الله وعن عظمة الله وعن شأن الله ، هي بطبيعة الحال أفضل من آية تتحدث عن أمر يتعلق بالخلق وخصوصاً إذا كانت نفسها أذى .
وهؤلاء لهم أدلة تدل على ذلك حيث جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما سمع الرجل يقرأ سورة الإخلاص، وكان الرجل يتقالها؛ أي يعتقد أنها قليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أنها لتعدل ثلث القرآن ” ما كانت لتعدل كلمات القرآن ( ثلثه ) وهي كلمات قليلة من حيث العدد إلا لفضلها ، ولذلك جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “أن (يس) قلب القرآن” ، وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “أن أعظم آية هي آية الكرسي” وجاء أيضاً “أنها انتزعت من تحت العرش ووصلت بسورة البقرة” فهذه الأحاديث كلها تدل على تفضيل بعض القرآن على بعض .
وأما من حيث البلاغة فقد ذكر السيد رشيد رضا بأن القرآن المكي أبلغ من القرآن المدني، ورد ذلك إلى أن القرآن المكي يخاطب قريشاً فهم ذؤابة العرب ، وكانوا في الذروة من البلاغة ، فلذلك جاء أبلغ ما يكون ، بينما القرآن الكريم جاء إما ليخاطب الأنصار وهم دون قريش في بلاغتهم ، وإما ليخاطب أصل الكتاب وهم دون قريش في بلاغتهم ، فلذلك كان دون القرآن المدني من حيث البلاغة ، والقرآن الكريم لم ينزل على بلاغة الناس في مخاطبتهم ، وإنما هو كلام الله عز وجل يفوق جميع بلاغات البلغاء ، وينظر إلى آيات التوحيد، الثاني نزلت بالمدينة المنورة لا نجدها تختلف عن الآيات التي نزلت بمكة المكرمة ، ومن شأن البلاغة أن يراعي فيها مقامات ، وقد تقتضي البلاغة تارة الإطناب وتارة الإيجاز ومراعاة الإطناب بالمدينة المنورة ، والإيجاز بمكة المكرمة كل من ذلك يعد بلاغة وتعد البلاغة غير متفاوتة ، فالقرآن لا تتفاوت آياته من حيث البلاغة ، وإنما تتفاوت في الفضل ، ومن حيث المحتوى كما تشير إلى ذلك الأحاديث النبوية عن صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام .
س5- السائل يسأل عن قوله سبحانه وتعالى ( أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)(الشورى: من الآية51) ما معناها؟ وما وجه البلاغة فيها ؟ !
ج- أن يسمع الصوت من غيره ولا يعلم من أين أتاه، هذا معنى ” أو من وراء حجابَ ” كما وقع ذلك لموسى عليه السلام، أما وجه البلاغة فيها فهو عبارة شاملة دالة على أن هذا السامع سمع هذا الصوت من حيث أحس بأنه قصد به خطاباً ولكن ما علم كيف أتاه ، هذا من وراء حجاب .
والآن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى التوفيق وأن يجمعنا على الخير والتوفيق وأن يلهمنا الرشد. وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين ” سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين “.
تمت المحاضرة