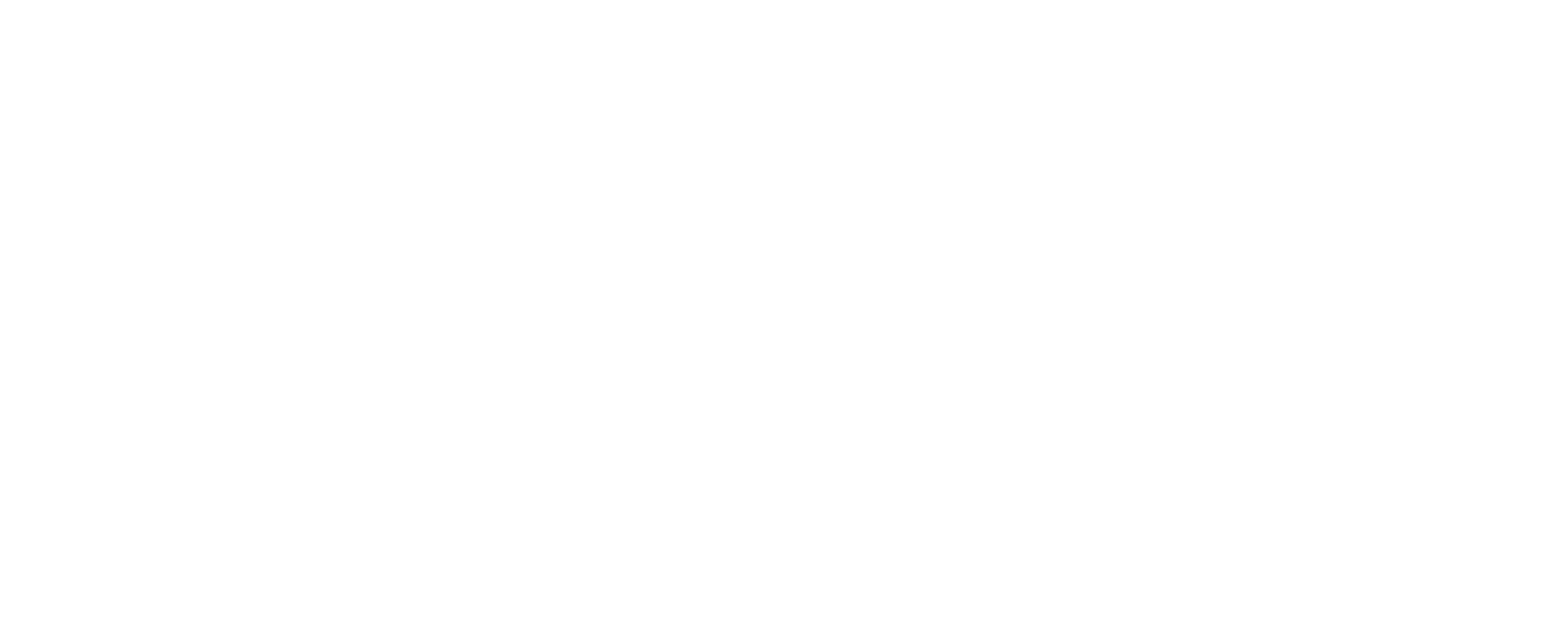سورة الهمزة:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
{وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1)} (لعله) قيل: هم المشاؤون بالنميمة؛ وقيل: الهمز في الغيب، (لعله) واللمز في الوجه؛ وقيل: الهماز: النمام؛ واللامز: المغتاب، { الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2)} وجعله عدة للنوازل؛ أو عدة مرة بعد أخرى تلـهيا به، {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3)} تركه خالدا في الدنيا، فأحبه كما يحب الخلود؛ أو حب المال أغفله عن الموت؛ أو طول أمله، حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يظن الموت؛ وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي للآخرة.
{كَلَّا} ردع له عن حسبانه، أي: لا يخلده ماله، { لَيُنْبَذَنَّ} ليطرحن {فِي الْحُطَمَةِ (4)} في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يطرح فيها. { وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5)}؟ ما النار التي لـها هذه الـخاصية، {نَارُ اللَّهِ} تفـسيرا لها، {الْمُوقَدَةُ (6)} التي أوقدها الله، وما أقدره لم يقدر أن يطفئه غيره، {الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7)} تعلو أوساط القلوب وتشتمل عليها؛ وتخصيصها بالذكر، لأن الفؤاد ألطف ما في البدن وأشده تألما، أو لأنه محل العقائد، ومنشأ الأعمال، به يثبت الثواب والعقاب.
{إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8)} مطبقة؛ من أوصدت الباب إذا أطبقته، {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)} أي: موثقين في عمد، مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص.
*************************
سورة الفيل:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1)}؟ الخطاب للرسول، وهو وإن لم يشهد تلك الواقعة لكن شاهد آثارها، وسمع بالتواتر أخبارها، فكأنه رآها؛ وإنما قال: كيف، ولم يقل ما ، لأن المراد: تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله وقدرته.
{أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2)} في تضييع وإبطال؛ وقيل؛ وقيل: في تضليل عن ما أرادوا.
{وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3)} قيل: كـثيرا متفرقة يتبع بعـضها بعـضا، {تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)} قيل: كورق الزرع،وقع فيه الأكال، وهو أن يأكله الدود؛ أو أكل حبه، فبقي صفرا ]منه[؛ أو كتبن أكلته الدواب وراثته؛ فصاروا أشباحا بلا أرواح، وهم في الحياة كذلك في الحقيقة.
****************
سورة قريش:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
{لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)} قيل: كانت لقريش رحلتان للميرة، (لعله) من الشام رحلة في الشتاء، ورحلة في الصيف، وكانوا يتىلفون ويدفنون ما بينهم من الأحقاد والضغائن، لأجل حاجتهم للميرة؛ فأمرهم تعالى أن يتآلفوا على عبادته ولزوم طاعته، كما يألفون للرحلة.
*************************
سورة الماعون:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1)}؟ بالجزاء، { فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2)} يدفعه عن حقه وصلته دفعا عنيفا، { وَلَا يَحُضُّ} غيره { عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3)} لعدم اعتقاده بالجزاء.
{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)} غافلون غير مبالين بها، {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6)} يراءون النـاس بأعمالهم ليروهم الثناء عليـهم، {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} اللازم من أموالهم؛ والمعنى: إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ، فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين، والرياء الذي هو شعبة من الكفر، ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك، ولذلك رتب عليها الويل؛ أو للتنبيه على معنى: فويل لهم؛ وإنما وضع المصلين مع الضمير للدلالة على معاملتهم مع الخالق والخلق، لأنه إذا استقامت أحوالهم مع الخالق، استقامت مع الخلق، فإن فسدت مع الخالق كانت مع الخلق أفسد.
ومن تفسير جامع الجوامع: أي: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب، وينكر البعث من هو؟ إن لم تعرفه {فذَلِكَ الذِي} يكذب بالجزاء وهو {يدعُّ اليتيم}، أي: يدفعه دفعا عنيفا، بجفوة وغلظة، ويرده ردا قبيحا بزجر وخشونة، {وَلاَ يَحضُّ} ولا يبعث أهله {عَلَى} بذل {طعام المسكين}، فلا يطعمه ولا يأمر بإطعامه. جعل الله سبحانه علم التكذيب بالجزاء منع المعروف، والإقدام على إيذاء الضعيف؛ يعني: أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالحسنات ورجا الثواب، وخاف العقاب، لما قدم على ذلك، علم أنه مكذب. فما أشد هذا من كلام، وما أخوفه من مقام، وما أبلغه في التحذير من ارتكاب المعاصي والآثام؛ وإنها جديرة بأن يستدل بها على ضعف الإيمان؛ ثم وصل به قوله: {فويلٌ لِّلمصلِّين} كأنه قال: فإذا كان الأمر كذلك، فويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة قلى مبالاة بها حتى تفوتهم أو يخرج وقتها؛ أو يستخفون بأفعالها، فلا يصلونها كما أمروا في تأدية أركانها، والقيام بحقوقها وحدودها؛ لكن ينقرونها نقر الغراب من غير خشوع وإخبات، واجتناب المكروهات من العبث بالشعر والتثاؤب والتمطي والالتفات، الذين عادتهم الرياء والسمعة بأعمالهم، ولا يقصدون بها الإخلاص والتقرب إلى الله على وجه الاختصاص، ويمنعون حقوق الله تعالى في أموالهم؛ والمعنى: إن هؤلاء هم الإحقاء بأن يكونوا ساهين عن الصلاة التي هي عماد الدين، والفرق بين الإيمان والكفر؛ وملتبسين بالرياء الذي هو شعبة من الشرك، ومانعين للزكاة التي هي قنطرة الإسلام، وتكون صفاتهم هذه علما على أنهم مكذبون بالدين، مفارقون لليقين.
وعن أنس:» الحمد لله على أن لم يقل: في صلاتهم « . والمراءاة: مفاعلة من الإرادة، لأن المرائي يري الناس عمله، وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به، ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها، لقوله عليه السلام: »ولا غمة في فرائض الله« لأنها شعائر الدين وأعلام الإسلام؛ وقوله عليه السلام: »من صلى الصلوات الخمس جماعة، فظنوا به كل خير« ؛ وقوله عليه السلام لأقوام لم يحضروا الجماعة:»لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم«؛ ولأن تاركها يستحق الذم والتوبيخ، فوجبت إماطة التهمة بالإظهار. وإن كان تطوعا فالأولى فيه الإخفاء، لأنه مما لا يلام بتركه، ولا تهمة فيه، فيكون أبعد من الرياء؛ فإن أظهره قاصدا للاقتداء به كان حسنا؛ فإنما الرياء أن يقصد بإظهاره أن يراه الناس فيثنوا عليه بالصلاح؛ على أن اجتناب الرياء أمر صعب غلا على المخلصين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :»الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة على المسح الأسود«.
واختلف في »الماعون«، فقيل: الزكاة؛ وقيل: هو ما يتعاون الناس بينهم، من الدلو والفأس والقدر، وما لا يمنع كالماء والملح«. انتهى الذي من كتاب ”جامع الجوامع“.
*************************
سورة الكوثر:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} الكوثر، ”فوعل“، من الكثرة، وهو الخير المفرط في الكثرة، من العـلم والعمل، وشرف الـدارين. وقيل: عن ابن عـباس أنـه فسر »الكوثر« : بالخير الكثير، وقد أعطاه الله سبحانه ما لا غاية لكثرته من خير الـدارين، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} فدم على الصلاة خالصا لوجه الله، خلاف الساهي عنها المرائي فيها، شكرا لإنعامه؛ فإن الصلاة جامعة لأقسام الشكر، {وَانْحَرْ (2)} البدن التي ]هي[ خيار أموال العرب، وتصدق على المحاويج، خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون؛ فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة، وقد فسرت الصلاة: بصلاة العيد، والنحر بالضحية.
{إِنَّ شَانِئَكَ} إن من أبغضك لبغضه لك، {هُوَ الْأَبْتَرُ (3)} لا أنت، والأبتر من خير الدارين؛ كما أن الكوثر هو خير الدارين. والوعد بخير الدارين يعم كل من كان على طريقته، والوعيد بانقطاع خيرهما يعم كل من عاداه، فلا يرجى منه ولا فيه ولا له خير، بل كل شر محيط به.
فانظر في نظم هذه السورة الأنيق، وترتيبه الرشيق، مع قصرها ووجازتها تبصرة، كيف ضمنها الله النكت البديعة، حيث بنى الفعل في أولها على المبتدأ، ليدل على الخصوصية؛ وجمع ضمير المتكلم ليؤذن بكبريائه وعظمته؛ وصدر الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم؛ وأتى بالكوثر محذوف الموصوف، ليكون أدل على الشباع، والتناول على طريق الاتساع، وعقب ذلك بفاء التعقيب، ليكون القيام بالشكر الأوفر مسببا عن الإنعام بالعطاء الأكبر.
وقوله: {لَربِّكَ} تعريض بدين من يعرض له بالقول المؤذي، من ابن وائل وأشباهه مما كانت عبادته ونحره لغير الله. وأشار بها ]كذا[ بين العبادتين إلى نوعي العبادات: البدنية التي الصلاة إمامها،والمالية التي نحر البدن سنامها؛ وحذف اللام الأخرى إذ دلت عليهما الأولى، ولمراعاة حق التشييع الذي هو من جملة نظمة البديع؛ وإلى ]الرسول صلى الله عليه وسلم[ بكاف الخطاب على طريقة الالتفات، إظهارا لعلو شأنه، وليعلم بذلك أن من حق العبادة أن يقصد بها وجه الله خالصا.
ثم قال: {إنَّ شَانِئك} فعلله ما أمره به من الإقبال على شأنه في العبادة بذلك، على الاستئناف الذي هو جنس من التعليل رائع. وإنما ذكره بصفته لا باسمه، ليتناول كل من أتى حاله، وعرف الخير ليتم به البتر، وأفخم الفضل لبيان أنه المعين لهذا النقص والعيب. وذلك كله مع علو مطلعها وتمام مقطعها، وكونها مشحونة بالنكت الجليلة، متكثرة بالمحاسن غير القليلة، مما يدل على أنه كلام رب العالمين، الباهر لكلام المخلوقين؛ فسبحانه لو لم ينزل إلا هذه السورة الواحدة الموجزة، لكفى به آية معجزة، لو هم الثقلان أن يأتوا بمثلها، لشاب الغرب، وساب كالماء السراب قبل أن يأتوا بها.